الدكتور عادل عامر
تتمثل خطورة “الهشاشة العمرية ” في أنها تُفقد صاحبها أمرين أساسيين: “الأصالة الفكرية”، والمناعة الذاتية”. وغياب “الأصالة” يؤدي إلى عدم القدرة على التعبير عن النموذج الفكري الذي يتبناه وينطلق منه؛ بينما “غياب” المناعة يجعله في مهب الريح أمام الأفكار الوافدة، لا يصمد أمام فكرة مخالفة. ولهذا نرى الشباب سهل الانقياد والتأثر بما يُطرح عليه في الفضاءات المفتوحة، من منتديات ووسائل تواصل.. تجذبه الأضواء ولو كانت تُخفي وراءها ظلامًا، ويستهويه البَّراق ولو كان زائفًا أو سرابًا..! فكم نرى انسياق الشباب خلف ما يسمَّى “الموضة”، لاسيما الفتيات، حتى صار التقليد أسلوب حياة، دون تمحيص لما يجوز وما لا يجوز..
المهم ألا يبدو أحدهم غيرَ مواكب للعصر، أو غريبًا عن أقرانه! وكم نرى الافتتان بفكرة وافدة، لمجرد أنها تتخفَّى بشعارات جوفاء زائفة؛ ولا نحاول أن نقيس هذه الفكرة بما لدينا من “ميزان” ومنهج ونموذج يعبِّر عن ذاتيتنا وأصالتنا..
مثلما رأينا في فترة من تاريخنا المعاصر، عند رواج الفكر الاشتراكي، كتاباتٍ تتبنّى ذلك وتروّج لما يسمَّى “اشتراكية الإسلام”؛ وإنْ كانت النية حسنة تريد أن تُبرز سبقَ الإسلام في تحقيق “العدالة الاجتماعية“،
وعدمَ تعارضه مع أي فكرة تصب في هذا الاتجاه.. لكن البعض لا يهمه أن يبحث عن التوافق مع الإسلام، بقدر ما يهمه جرَّ الإسلام إلى مساحته هو، والعبث بالمفاهيم الإسلامية وتلوينها بحسب ما يريد! فالهشاشة الفكرية تجعل الأمة تفقد أعز ما تملك من ثروة، أي الشباب؛ فتصبح مهددة في مستقبلها وعماد نهضتها.. كما تجعلها معرَّضة لفقدان الهوية الذاتية؛
التي تحفظ لها كينونتها وأصالتها ومناعتها، وتُبقي لها معالمها وثوابتها؛ بعيدًا عن الجمود أو الذوبان أو الاختراق. في أسباب الهشاشة وأما إذا تأملنا أسباب هذه الظاهر ذات الآثار الخطيرة، فيمكن أن نشير إلى أن “الهشاشة الفكرية” ترجع أول ما ترجع إلى غياب التحصين الفكري وعدم الانطلاق في تبني الآراء والمواقف من قناعات ذاتية راسخة. فنجد أحد الشباب يمارس شعائر الإسلام ويقر بأنه الدين الصحيح.
. لكنه لا يمارس ذلك بعد قناعة راسخة خضعت للمعرفة الصحيحة، وإنما انطلاقًا من أنه نشأ لأبوين مسلمين وفي بيئة مسلمة، فالتزم بما تلتزم به؛ التزامًا أقرب للتقليد منه إلى القناعات! وكذلك نجد فتاة تلتزم بالحجاب ولا تتبرج، لكن ليس عن إدراك لأهمية ما تلتزم به، ولفرضيته، ولما يمثله من قيم؛ وإنما لأنها نشأت في أسرة أو بيئة تلتزم بهذا الزي.. فهي أيضًا إلى التقليد أقرب! فإذا ما واجه هذا الشابُ أو هذه الفتاة مَن يشكك فيما تعودا أن يلتزما به؛
فإنهما لا يستطيعان حينئذ الدفاع عن موقفيهما، بل ربما سهل عليهما الانخداع بما يواجهان من افتراءات، وأخَذَا في ترديدها.. ولهذا، كثيرًا ما يفاجأ الأبوان بأن أحد أبنائهما قد أعلن إلحاده، أو يعتنق أفكارًا غريبة، أو انجرَّ إلى سلوكيات مرفوضة بحجة الموضة واختلاف الأجيال وخصوصية الشباب! ومن هنا، حمل القرآن الكريم على التقليد ودعا إلى النظر والتفكر والمراجعة؛ لأن التقليد لا يبني موقفًا حقيقيًّا راسخًا، وإنما ينشئ أوضاعًا مهتزة، وقد يقود إلى اتباع الباطل: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} (البقرة: 170).
كما نلاحظ في أسباب الهشاشة ضعف منافذ التعليم والتوجيه؛ من الأسرة والمدرسة والمجتمع، بما يجعل التعليم يتحول إلى مجرد معلومات لا أثر لها في تكوين القناعات الراسخة ولا في تثبيت السلوك القويم.. وبما يُضعف من تأثير الأسرة والمجتمع؛ خاصة بعد انشغال الأبوين في دوامة الحياة وتوفير حاجات المأكل والمشرب، وتقلُّصِ دورهما التربوي..
في معالجة الهشاشة إذن، نحتاج في معالجة “الهشاشة الفكرية” إلى: – التحصين الفكري، لاسيما عند الشباب: ولا يكون ذلك إلا بتثبيت الهوية، وعدم السماح بما ينال منها.. فتترسخ القناعات، ويتقوّى الجهاز الفكري. – تفعيل دور الأسرة والمدرسة والمجتمع: في التربية والتعليم والتوجيه؛ لكي تتكامل هذه المؤسسات في التوعية المطلوبة، ولا يكون المرء نهبًا لضوءٍ لامع أو شعار جذّاب. – تطوير مناهج التعليم: حتى تؤدي إلى إنضاج قدرة الشباب على التفكير والحوار والنقد والتمحيص. – إدخال مقرر للثقافة الإسلامية في جميع مراحل التعليم: بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة تعليمية؛ بحيث يتعرف الشباب على أصول الإسلام، ومعالمه الأساسية، ورؤيته الكلية في مناحي الحياة ونُظُمها.. بلغة ميسورة، ومنهج حواري مُقْنِع..
حتى نحقق للشباب الانطلاق من أرضية ثابتة، ونوفر له المناعة الفكرية المطلوبة. – إتاحة الساحة والمنابر للعلماء الراسخين: الذين يمتلكون القدرة على مخاطبة العقول، ومواجهة الشبهات، ومحاورة الشباب بالتي هي أحسن وأرشد وأقنع.
إن التحديات الفكرية التي تواجه مجتمعاتنا، تتطلب أن نعمل وبجدٍّ على بناء فكري راسخ.. ينطلق من هويتنا وأصالتنا باعتزاز لا جمود فيه، ويتحاور مع الآخرين دون ذوبان، ويبحث عن الحكمة والفائدة أينما وُجدت.. وإذا كان هذا هو التوجيه الفكري فان التوجيه النفسي يوضح لنا معالم الطريق في التربية الدينية للوصول إلى الهدف المرسوم وهو الشخصية التي تحس بالحق وتؤمن به، ويثمر فيها بمراعاة تدرج القامات النفسية والروحية.
إن التوجيه النفسي يرمي إلى أن يتقبل الفرد نفسهُ التي خُلقت على صورة الله ومثاله ويتعرف على جمالها وقوتها ويتحسس وزناتها ليتاجر بها ويربح.
أن التوجيه النفسي يرمي إلى أن تكون الشخصية متكاملة لأن المسيحي الحقيقي ذو شخصية قوية ولكن ليست فيه الذاتية والكبرياء، وإنما مشيئته هي مشيئة الآب ولم تعد له مشيئة خاصة، وهذا هو معنى إهلاك الذات: أن يكون الله هو الكل في الكل. إن التوجيه النفسي يرمي إلى أن يختبر الفرد حياة الحب والبذل والعطاء فيجدها حياة كلها ربح (وليست خسارة كما يدعي أهل العالم). تربحه روحيًا وهذا هو أهم ما يترجاه إذ يتقابل في محبته للناس بالرب طالما هو لا يهدف من هذه المحبة مجدًا ذاتيًا أو خدمة بشرية تعود عليه بصيت وسمعه ومحبة متبادلة من الناس، وتربحه نفسيًا إذ تصير نفسيته مستريحة بعيدة عن كل كبت وضغط وحرمان، لأن طبيعة المحبة تُصّير النفس في حياة السلام والفرح والطمأنينة وهي أيضًا تربحه اجتماعيًا إذ أن الناس يحبونه ويقدرون مبادئه، ولكن هذه الناحية الأخيرة إذا لم تتحقق فهو لا يهتم بها طالما هو أمين في محبته، إذ سيأتي وقت في حياته أو بعدها يقدرون مبادئه عندما تلمس النعمة قلوبهم وتوجههم نحو هذه المبادئ، وإذا تحققت فإنه لا يقبل لنفسه مديحًا ومجدًا وإنما يعطي المجد لله وتظل حياته خالية من الكبرياء والذاتية والاهتمام بالنفس. بذلك يكون التوجيه النفسي للمنهج هو أن يتقابل مع نفسه فيقدمها للمسيح محرقة، تعمل نيران الروح القدس فيها فتحيل العادات والاتجاهات والعواطف إلى دوافع متمركزة حول محبة الله. وهذا يتفق مع ما ذكر في التوجيه الاجتماعي والروحي أن المنهج يسمو إلى تكوين شخصيات محبة، والمحبة فيها نابعة من فاعلية الروح القدس في القلب.
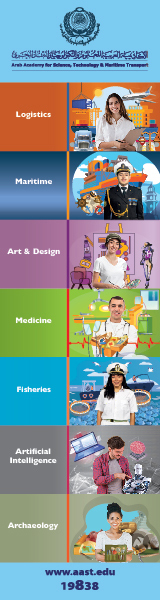
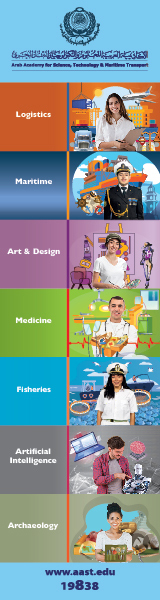
 جريدة هرم مصر حقيقه بدات
جريدة هرم مصر حقيقه بدات



