كتب /د.عادل عامر
العلاقات الاجتماعية: هي الروابط والآثار المتبادلة التي تنشأ نتيجة اجتماع الناس وتبادل مشاعرهم واحتكاكهم ببعضهم، ومن تفاعلهم في بوتقة المجتمع وقد بيَّن الله عز وجل أن العلاقة بين البشر تقوم على أساس التعارف والتكامل، وأن ميزان الأفضلية هو التقوى والعمل الصالح، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [الحجرات: 13).
ومن هنا يقرر ابن خلدون أن الإنسان مدني بالطبع، وهذا يعني أنه لا يمكن للفرد أن يعيش حياته بعيدًا عن البشر، فلا يتم وجوده إلا مع أبناء جنسه، وذلك لما هو عليه من العجز عن استكمال وجوده وحياته، فهو محتاج إلى المعونة في جميع حاجاته أبدًا بطبعه
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين في القرآن الكريم:
هناك دلائل عديدة تؤكد ربانية النظام الاجتماعي، من ذلك تلك النصوص الشرعية التي تطلب من المجتمع المسلم التطبيق الكامل لتشريعات الوحيين (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً) [البقرة: 208]، يقول ابن كثير: يقول الله تعالى آمرًا عباده المؤمنين به المصدّقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك، فالنص القرآني واضح في أنه يطالب المجتمع المسلم أن يلتزم بالنظام الرباني الذي شرعه الله تعالى للعباد، وأن يتم تطبيق النظام في المجتمع بصورة كاملة، وبهذا يكون مجتمعًا إسلاميًّا مسالِمًا ربانيًّا
وأقام الإسلام العلاقة بين المؤمنين على أساس متين من الأخوَّة، قال الله عز وجل: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات: 10] قال الرازي قال بعض أهل اللغة: الإخوة جمع الأخ من النسب، والإخوان جمع الأخ من الصداقة، فالله تعالى قال: “إنما المؤمنون إخوة” تأكيدًا للأمر وإشارةً إلى أن بينهم ما بين الإخوة من النسب،
الجَوهرُ الإنساني هو المِحَكُّ الأساسي في مسار الأحداث اليومية، ووفق هذه الأحداث يتم تأسيس تاريخ شخصي للكَينونة الإنسانية، يتَّصف بالاتِّزانِ رُوحًا ومَادَّةً، والتوازنِ نَوْعًا وكَمًّا. والجَوهرُ الإنساني هو الحاملُ للسِّياقات الثقافية بِكُل عناصرها الواقعية والذهنية، والحاضنُ للمعاني الاجتماعية والتاريخية. وهذا يُعطي زخمًا فلسفيًّا للفِعل الاجتماعي، ويُؤَسِّس شرعيةَ التفسير المعرفي للذاتِ الإنسانية ومُحيطِها الفكري على مشروعية الظواهر الثقافية، ودَورها المِحوري في تَشييد الحقيقة الاجتماعية كبناء أخلاقي وإطار لُغوي ونظام معرفي.
تشكيلُ العلاقات الاجتماعية لا يتم بِمَعْزِل عن سِياقِ التجارب اليوميَّة، وماهيَّةِ المعنى الوجودي، ومسارِ الوَعْي التاريخي. وكُلُّ علاقة اجتماعية تُمثِّل نظامًا معرفيًّا يُساهم في تكوين آلِيَّات لتفسيرِ الشخصية الإنسانية، وتأويلِ انعكاسات الفِعل الاجتماعي، وربطِ الظواهر الثقافية بالقوى التي تُولِّدها، بحيث تُصبح الثقافةُ سياسةً اجتماعية، ويُصبح المجتمعُ تيارًا ثقافيًّا مُتَدَفِّقًا،
لا يَخضع لإفرازات التاريخ، وإنما يُساهم في صناعة صَيرورة التاريخ، وبذلك يصبح المجتمعُ زمنًا جديدًا للمعنى الوجودي والوَعْي التاريخي. والمجتمعُ الحقيقيُّ لا يَنتظر المَوْجَةَ الفكرية كي يَركبها، وإنَّما يَصنع مَوجته الفكرية التي تنتشل الشخصيةَ الإنسانية من الغرق في الاستهلاكية المادية الفَجَّة. والفِكرُ الاجتماعي الحقيقي لا يَسير معَ التيار، وإنَّما يكون هو التيارَ، الذي يَستقطب الأفكارَ الإبداعية، ويُوظِّفها معنويًّا وماديًّا مِن أجل إقامة الكِيان الإنساني على قواعد البناء الاجتماعي.
عِندما يُصبح الأفرادُ آلاتٍ ميكانيكية في هُوِيَّة التاريخ المركزية في الزمان والمكان، فإنَّ الوَعْي لَن يَقْدِر على تفسير الشُّعور الذي يُساهم في تفعيل سُلطة المعايير الأخلاقية، والشعور لَن يَقْدِر على إنشاء روابط إنسانية تُساهم في تكريس سِيادة المعنى اللغوي.
وإذا اختفت الأخلاقُ واللغةُ فإنَّ النظام الحياتي سَيَغرق في الأوهام. وعندما تُصبح الظواهرُ الثقافيةُ أدواتٍ نفعية في ماهيَّة الواقع الاجتماعية في الظاهر والباطن، فإنَّ المعرفة لَن تَقْدِر على تحليل البُنية التي تَعمل على تجذير شرعية الرموز اللغوية، والبُنية لَن تَقْدِر على توليد أفكار إبداعية تَعمل على تكوين هَيكلية الأسئلة الوجودية.
وإذا اختفت الرمزيةُ والأسئلةُ فإنَّ المنظومة الحضارية سَتَسقط في الفراغ. لذلك، لا بُدَّ مِن صِياغة العلاقات الاجتماعية روحيًّا وماديًّا بشكل مُستمر في البُنى الوظيفية المُتَحَكِّمَة بمسار المجتمع، وكشفِ العناصر المنبوذة والأفكار الهامشية في تفاصيل الجسد الاجتماعي، لتحديد التيارات الفكرية التي تمَّ تأسيسها للسَّيطرة على تشابكات النظام الحياتي والمنظومة الحضارية في أعراف المجتمع وقوانين الطبيعة .
ولا شَكَّ أنَّ الهوامش تدلُّ على المتن، والأطراف تدلُّ على المركز ، وبِضِدِّها تتبيَّن الأشياء. إن سائر الأعمال الصالحة من عبادات أو أعمال خير لها دور في نجاة المؤمن من أهوال يوم القيامة، فسائر الأعمال الصالحة هي طريق المؤمن إلى الجنة، وسوف نستعرض نماذج من الأعمال التي تنظم العلاقات الاجتماعية ويترتب عليها ثواب في ساحة الحشر قبل أن يتجاوز المرء ساحة الحساب إلى مستقرة الأخير.
يحقق إلى أي مدى يمكن الاستدلال على العلاقات الاجتماعية بين الناس من الأحداث المشتركة في الزمان والمكان. إذا عاش شخصان في نفس الموقع الجغرافي في الوقت نفسه، إلى أي مدىً يرجح أن يعرفا بعضهما البعض؟ هذا السؤال له آثار عميقة في الخصوصية، لا سيما بالنسبة للطرق التي يمكن من خلالها الاستدلال على الهياكل الاجتماعية من السجلات العامة على الأنترنت التي تلتقط مواقع الأفراد جسدياً على مر الزمن. يطور إطار عمل إحصائي للإجابة على هذه الأسئلة باستخدام البيانات المتاحة للجمهور من موقع وسائل الأعلام الاجتماعية، ويخلص إلى أنه حتى عدد قليل جدا من الحوادث المشتركة يمكن أن تؤدي إلى احتمال تجريبي عال ٍ من الرابطة الاجتماعية.
حين التأمل في مسيرة المجتمعات الإنسانية، نجد أن نظام العلاقات الداخلية يقوم على ركيزتين أساسيتين وهما : نظام العقد ومنظومة الحقوق والواجبات، التي تنظم العلاقة بين أبناء المجتمع في مختلف دوائرهم ومستوياتهم وإن هذا النظام هو الذي يحدد معيار العدالة الاجتماعية وسبل إنجازها.. وإن هذا النظام هو الذي يحول دون الانحدار إلى الفوضى في العلاقات والوقائع الاجتماعية المختلفة.
والنظام الآخر هو ما يمكن تسميته بنظام الرحمة.. بمعنى أن هذا النظام هو الذي يعطي للعلاقات الاجتماعية بعدها الإنساني والأخلاقي . وهذه القيمة تتكفل بسد الثغرات الناتجة من التطبيق الحرفي للنظام التعاقدي.. والمجتمع أي مجتمع لا يمكن أن تستقر أحواله وتتطور حياته بدون هذين النظامين. فالمجتمع لا يمكنه أن يعيش بنظام الرحمة، دون وجود منظومة قانونية توضح دائرة الحقوق والواجبات، كما أن المجتمع يصاب باليباس الأخلاقي والسلوكي، حينما تتراجع قيمة الرحمة في فضائه الاجتماعي . وعليه فإن المجتمع يحتاج إلى القانون، كما يحتاج الرحمة والبعد الإنساني . ونود في هذا المقال أن نركز على نظام أو قيمة الرحمة في العلاقات الاجتماعية .
على ضوء التجارب الإنسانية المتعددة، نستطيع القول إن الجوامع المجردة في الكثير من الأمم والشعوب والأوطان، لم تتمكن من ضبط خصوصياتها وصياغة فضاء وهوية مشتركة حقيقية. لذلك فإن المطلوب: ليس الاكتفاء والركون المجرد إلى الجوامع والقيم المجردة التي عادة الناس لا يختلفون حولها. وإنما الأمم والشعوب دائماً، هي بحاجة إلى تنمية المصالح المشتركة وربطها بواقع الحياة اليومية. حتى يتسنى للجهد الفردي والجمعي المبذول يومياً، أن يعمق ويجذر أسس تشابك المصالح ووحدة المصير.
فالمثل والمبادئ العامة، بحاجة دائماً في الإطار الاجتماعي أن تتسرب إلى تفاصيل الحياة الاجتماعية، وتكون جزءاً من النسيج الاجتماعي. ولاشك أن عملية تنزيل هذه المثل والمبادئ على الوقائع الاجتماعية المتحركة والمتغيرة دوماً، لا يمكن أن تتم بدون وجود مصالح مشتركة حقيقية، تربط بين كل أطراف المجتمع الواحد.
فالوحدات الاجتماعية والوطنية، لا تصنع بالمجردات من الدوافع والبواعث والمسوغات، وإنما هي تصنع بالحياة المشتركة على الصعد كافة. وهذا بدوره بحاجة إلى تنمية كل العلائق والروابط الاجتماعية بدوائرها المتعددة، والاقتصادية بمستوياتها المختلفة، والإنسانية بآفاقها الرحبة، والثقافية بتفاصيلها ووقائعها اليومية والرمزية. وكل هذا أيضاً بحاجة إلى سياج أخلاقي يتحصن به أفراد المجتمع، قوامه العفو والتسامح واللين والرفق وحسن الظن وما أشبه. وهي قيم ومثل أخلاقية وسلوكية قادرة على امتصاص أخطاء البشر وتشنجاتهم، كما أنها كفيلة بضبط النزعات النفسية والاجتماعية التي قد تساهم في تدمير الحياة المشتركة.
لذلك نجد أن القرآن الحكيم، يؤكد على هذه القيم، ويعتبرها أنها قادرة على تحويل المواقف وضبط العداوات كمقدمة لإنهائها. إذ يقول تبارك وتعالى: (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)، (فصلت 34 ).
فالأخلاق الفاضلة والتعامل الحسن والحضاري مع الآخرين، يساهم بشكل مباشر، في نزع الغل والأحقاد من النفوس، وغرس قيم المحبة والاحترام. وقال عز من قائل (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون)، (آل عمران 103)
وبإمكاننا أن نكثف هذا السياج الأخلاقي المطلوب، بكلمة واحدة وهي (الرحمة). إذ هي جوهر المحبة والألفة وضد التنافر والكراهية. فهي الأصل النفسي والأخلاقي الذي يفيض بالخير بمختلف أبعاده.
وهي الروحية التي تقدر الآخرين وتحترمهم، فتحبهم وتشفق عليهم، وتتمثل كلمة طيبة حانية، ولمسة رقيقة، وعوناً في الشدائد، وحسنا في الجوار، وما لا يحصى في الأقوال والأفعال، لتعكس على كل ذرة في هذا الوجود، وعلى كل شكل من أشكال العلاقة مع الإنسان الفرد والجماعة.
فتكون بذلك أصيلة في النفس بدون ضغط أو تكلف، ودخيلة في صياغة كل علاقة مهما كانت بسيطة.
لذلك نجد أن الرحمة في المنظور الإسلامي، هي أهم صفة وصف الله تعالى بها نفسه، وهي ركن في التشريع، وهي جميع الأخلاق، وهي التي يجب أن تسود حتى في حال الحرب والقسوة، لأن غاية الحرب الوصول إلى الهدى، إلى الله ورحمته.
وهي مطلوبة مع الجماد عناية به وتصرفاً سليماً به. ومطلوبة مع البهائم رفقاً بها حية، وعدم القسوة عليها ذبيحة. ومطلوبة إنسانياً بتجلياتها محبة ورفقاً وشفقة ومساعدة ونصيحة ونحوها. كما تقف ضد كل تجليات القسوة والشدة كالتباغض والتنافر والجريمة والظلم.
فالرحمة بكل تجلياتها وآفاقها، هي السياج الذي يحفظ الوحدات الاجتماعية من الانزلاق إلى مهاوي الصدام والشقاق.
فالاختلافات الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية، ليست مبرراً كافياً للخروج من سياق العدالة وممارسة الظلم بحق الآخرين تحت مبرر وعنوان الاختلاف العقدي أو السياسي.
فالقيم العليا للإنسان، لا تبرر بأي شكل من الأشكال ممارسة العسف بحق الآخرين لكونهم مختلفين معك في الرؤية أو الفكرة. فقيم العدالة واحترام الآخرين في ذواتهم وأموالهم وأعراضهم، حاكمة على كل قيم الاختلاف ومبررات العداء تجاه الآخرين. لذلك يقول تبارك وتعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون)، (المائدة 8 ).
وحينما تسند قيمة العدالة بقيمة الرحمة، تزول كل الأسباب والمنغصات التي تضر بواقع المجتمع واستقراره الداخلي، فالتراحم بين الناس بمختلف فئاتهم وشرائحهم، هو القادر على سد الكثير من نقاط الضعف والحالات الرخوة في المجتمع . فتعالوا آحادا وجماعات نلتزم بكل مقتضيات التراحم بيننا.
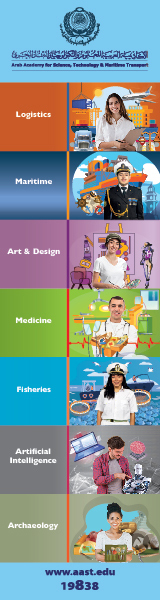
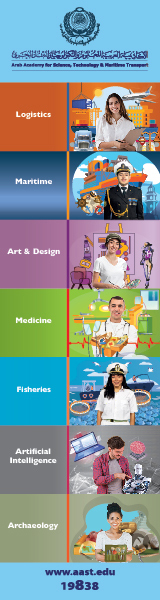
 جريدة هرم مصر حقيقه بدات
جريدة هرم مصر حقيقه بدات



