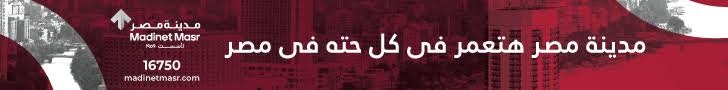كتب/د.عادل عامر
يشكل الفساد ظاهرة خطيرة حيثما حصل وكيفما تمت ممارسته، وينتج عنه مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، ويؤثر على القيم الأخلاقية والعدالة، وبالطبع يؤثر على تنمية المجتمع وسيادة القانون فيه، ويقترن الفساد بأشكال الجريمة، خصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، كما تتأثر موارد الدول والمجتمعات بممارسات الفساد المختلفة، مما يهدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لهذه الدول والمجتمعات، ولهذا اصبح الفساد ظاهرة ممتدة،
تؤثر على جميع المجتمعات والاقتصادات، فأصبحت مكافحة الفساد مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، مما يستدعي تعاونا بين الدول لمكافحته والحد منه ومن آثاره، بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، فتعمل المجتمعات والحكومات على انشاء مؤسسات تعزز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة.
وقد حاربت مختلف الاديان الفساد، واحتوت على مبادئ سامية وأخلاقيات عالية تدعو الى الصلاح والإصلاح والنزاهة، وتؤكد على حسن التصرف والادارة السليمة، ولجأ المشرّعون في مختلف دول العالم الى تجريم الفساد ووضع القوانين المحاربة له، كما رفضت المجتمعات على اختلاف مستوياتها الفساد ورفضته، وذلك لما كان للفساد من نتائج سلبية على المنظومات الاجتماعية، وتأخرت برامج النهضة والتنمية المجتمعية والوطنية بسبب الفساد والفاسدين والمنتفعين، وبسبب سوء استخدام الموارد، وسوء الادارة والتنظيم.
والحديث عن الفساد لا يخص مجتمعا بعينه ولا دولة بذاتها، انما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول وبدرجات متفاوتة، تحمل اخطارا كبيرة على النمو الاقتصادي والانفاق الحكومي والاستثمار، وبدأت المجتمعات بالبحث عن اساليب الوقاية من الفساد، ومعالجة آثاره ونتائجه.
ونظرا لكون الفساد المالي والاداري ظاهرة عالمية سريعة الانتشار والانتقال عبر الحدود، فقد اقتضى مواجهتها باساليب فنية متطورة، من بينها التثقيف حول مخاطر الفساد على المستوى الداخلي والخارجي الدولي، وتهيئة الارضية والبيئة التي تساعد اجراءات مكافحة الفساد أن تؤدي مفعولها، وتحقيق التعاون الدولي على المستوى التشريعي والقضائي فيما بين الدول والمجتمعات لمواجهة أشكال الفساد المختلفة ووضع الاجراءات الكفيلة بمنع الفساد أصلا ثم معالجة نتائجه حال حدوثها، ومنع توسع ظاهرة الفساد وانتشارها. الفساد بصورة أكفأ وأنجع، وترويج ودعم التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد
وثمة نهج دارج لمفهوم الفساد يرد في التعريف الذي تقترحه منظمة الشفافية الدولية. ووفقاً لهذا التعريف، فإن الفساد هو “سوء استعمال المرء للسلطة التي أؤتمن عليها لتحقيق مكاسب خاصة”
على أن هذا التعريف عام بالأحرى حيث يتسع لنطاق واسع من التصرفات المختلف. وخلافاً للأحكام التي ترد عادة في القانون الجنائي، التي تذكر جنايات بشكل محدد، فإن التعريف المذكور آنفاً تترك الباب مفتوحاً. وفي الوقت نفسه، فإن وجود تعريف قائم على العناصر الثلاثة المحددة المتمثلة في “سوء الاستعمال” و”السلطة المؤتمن عليها” و”المكاسب الخاصة”، قد يعني استبعاد بعض التصرفات التي ينبغي أن تعتبر هي أيضاً من قبيل الفساد. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي استعمال (أو سوء استعمال) سلطة التُمست بصورة غير قانوني إلى الفساد.
فهذا التعريف الواسع بالأحرى يمكن مع ذلك بالتالي أن يكون ضيقاً جداً فيما يتعلق بأشكال محددة من سوء السلوك التي ينبغي أن تعتبر هي أيضاً من قبيل الفساد. تستخدم كلمة “الفساد” للتعبير عن مجموعة من السلوكيات غير الصحيحة كالرشوة والاختلاس وإساءة استخدام السلطة والابتزاز والإثراء غير المشروع والأتاوات والمتاجرة بالنفوذ،
بالاضافة الى افعال ترتبط بأنشطة الفساد الرئيسية، ويُلجأ إليها للمساعدة في الشروع بهذه الانشطة، كغسيل الاموال واعاقة سير العدالة او منعها، ويعرف الفساد بأنه أفعال أو جرائم تشكل ممارسات فاسدة، وتشترك هذه الأفعال والجرائم بعنصرين رئيسيين، الاول هو أنها تنطوي على إساءة استخدام السلطة في القطاعين العام والخاص، والثاني أن الاشخاص الذين يسيئون استخدام سلطاتهم يجنون من وراء ذلك منافع ليست من حقهم.
يتعلق الفساد بتجاوز القوانين والتشريعات والمنظومات القائمة، وبمخالفة قيم العمل والنظام العام، ويمكن وصف جميع مظاهر الانحرافات الادارية والتنظيمية والوظيفية التي يقوم بها الموظف أثناء أدائه لمهامه المناطة به بأنها شكل او مظهر او حالة من حالات الفساد، وهذا الوصف ينطبق على جميع القوانين والتشريعات والمنظومات ذات العلاقة بالأداء الاداري والمالي، والانحرافات والمخالفات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية والادارية، فالرشاوى والعمولات والاختلاسات والمحسوبية، وسوء اختيار الموظفين وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتجاوز التعليمات الادارية والتنظيمية والتقاعس في تحقيق اهداف المنشأة وغير ذلك، هذه كلها مظاهر فساد معروفة لا تخلو منها المجتمعات على مر العصور.
ورغم ان الفساد هو ظاهرة طبيعية مصاحبة لحالة النمو، فهو والحالة كذلك، ثمناً لا بد منه لدفع عجلة التنمية، لكن هذا ليس تبريراً ولا موافقة لوجود الفساد، بل انما المسألة هي توصيف لوجود الفساد من الناحية الوظيفية، وتلجأ القيم الدينية والمنظومات الاخلاقية الى محاربة الفساد وتعتبره مرضاً فرديا هدّاماً للشخص، حيث يفضل الشخص هنا المصلحة الشخصية على العامة بصورة غير شرعية، مخالفاً القيم التي تعهد بالمحافظة عليها، والشرائع والمبادئ التي ترفع من المجتمع ومنظوماته الفكرية والادارية والقانونية.
ويتعلق الفساد الاداري بمظاهر الانحرافات الوظيفية والادارية والتنظيمية الصادرة عن الموظف العام اثناء تأديته لمهامه الوظيفية متجاوزا القوانين والتشريعات ومنظومة قيم المجتمع، أما الفساد المالي فيتمثل في الانحرافات المالية ومخالفة الضوابط والأنظمة المالية، والتعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في الرشاوى والعمولات والاختلاسات والمحاباة والمحسوبية، ولا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات قديمها وحديثها من مظهر من مظاهر الفساد الاداري والمالي. يشمل الفساد في معناه العام كل اعتداء على الأنفس والأموال والموارد، ويقول رب العزة سبحانه وتعالى ” وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ
” البقرة ٢٠٥، ويشمل أكل الاموال بالباطل، حيث نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك في قوله:” ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وانتم تعلمون”، إنَّ مدلول الفساد في ألفاظ القرآن الكريم مدلول شامل لجميع أنواع الفساد وصوره. وقد جعل الشرع الحنيف المعاصي، كل المعاصي، فساداً في الأرض،
فكل المخالفات خروج عن جادة الصلاح، وانحراف عن الطريق المستقيم، سواء كانت هذه المخالفات في مجال السلوك أو مجال الجرائم الجنائية أو الحقوق المدنية أو الحقوق العامة. يتمثل الفساد من وجهة نظر المجتمع بسعي الموظف الى تحقيق المكاسب الشخصية باستغلال المنصب والوظيفة، وذلك بتفضيل الاقارب والمعارف ومنحهم الامتيازات دون غيرهم من ابناء المجتمع بغض النظر عن الكفاءة والاولوية، وتفضيل دعم القطاع الخاص المستفيد من المشاريع على حساب تنمية المجتمع وبإزدراء واضح للمنظومات الادارية والاخلاقية والقانونية والمجتمعية.
ويختلف الفساد من مجتمع الى اخر، وأشد انواع الفساد ضررا تلك هي التي تقع في المجتمعات النامية التي تفتقر الى وجود مؤسسات المجتمع المدني، ذلك أن هذه المؤسسات تساعد على كشف الاثار السلبية للفساد، وتؤدي حالات الفساد الى الافتقار الى عنصر الاحساس بالمسؤولية الوظيفية من قبل الموظف والقائم على الادارة وسط تزايد وتفاقم المشكلات الاقتصادية في المجتمع،
وبذلك تنهار النظم الادارية، فالظروف الاقتصادية تؤثر على منظومات القيم الاجتماعية وبالتالي على المنظومات الادارية المختلفة، ما ينجم عنه تلاشي آمال المجتمع تجاه قضايا الاعمار والبناء، واختلال موازين الفرد تحت وطأة الظروف الصعبة وعدم توفر القدرة على المساءلة القانونية، حيث يتمتع المسؤولون بحرية واسعة من التصرف مقابل قليل من المساءلة،
مما يجعل اولئك المسؤولين يسعون لاستغلال المواقع الادارية لتحقيق المكاسب الشخصية وتلقي الرشوة والعمولات من القطاع الخاص مقابل تسهيل اعطاء المشروعات على حساب المجتمع، ويأتي المسؤولون بأقاربهم ومعارفهم الى الوظائف ويساعدوهم في الحصول على مشاريع الدولة ليقبضوا مقابل ذلك مبالغ دون اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم، وبالتالي يفكر الموظف الفاسد في تحقيق المكاسب الشخصية بغض النظر عن تأخر المجتمع وتوقف خطط التنمية الفعالة في الوقت الذي يكون فيه المجتمع بأمسّ الحاجة الى برامج النهضة الحقيقية لإنقاذه وتطويره وتقدمه.
وتؤدي الممارسات الفسادية الى تداعيات نفسية واجتماعية خطيرة على المجتمع، فتزداد الامراض النفسية وتتفاقم الازمات الاجتماعية والتوترات الاسرية ويدب اليأس في صفوف افراد المجتمع وتصطدم برامج مكافحة الفساد بعقبات كثيرة لنقص دعم المجتمع وغياب المساءلة المجتمعية.
كما تؤدي الممارسات الفسادية في المجتمع الى تهديد مباشر للقيم الاخلاقية ذات العلاقة بالتنشئة الاجتماعية للاجيال الناشئة، وذلك لعدم الاهتمام بالجانب السلوكي لممارسات المسؤولين اثناء استغلال مناصبهم لتحقيق المكاسب الشخصية، والتي تنعكس هذه الممارسات على سلوك الاجيال الجديدة حينما إذا كانت النظريات يجب ان تبدأ من حيث تبدأ الموضوعات التي تتناولها،
فإن الظاهرة “الفساد” يجب ان يبدأ تأطيرها المعرفي من وصلة العلاقة بين الدولة كعقد اجتماعي محايد والحكومة كجهاز تنفيذي للدولة. ولأنه لا يمكن أن تستقيم نظرية ما وتصبح ذات قدرة تفسيرية أعلى، إلاّ إذا كان المنظور التاريخي ركيزتها الأولى، فالمعرفة الحقة تفترض بداهة معرفة الكل وليس أجزاء مختلفة متناثرة منه، وذلك لأن المعرفة تتغير وتتطور عندما تكون جزءاً من نسق معرفي أكبر. حاول الفلاسفة والمفكرون عند تأصيلهم لبعض المفاهيم وسبر أعماقها والإحاطة بها
أن يباشروا نشاطهم الفكري من خلال المقاربة المسماة بالثنائيات الضدية: الفساد والصلاح، الشر والخير. “فالفكر عامة يعتمد في نشاطه على الثنائيات الضدية وحوار الحدود المتقابلة وهو ما يسمى بالفلسفة الجدلية أو (الديالكتيك) أو الحوار
وكثيراً ما يحاول طرف من الثنائية أن يشل حركة الطرف الآخر أو يهيمن عليه أو يقهره أو يطمسه: الخير/ الشر، الحق/ الباطل، الفساد/ الصلاح، القوي/ الضعيف، الغني/ الفقير.
عرف المعجم الفلسفي الثنائية: “بأن الثنائي من الأشياء ما كان ذا شقين، والثنائية هي القول بزوجية المبادئ المفسرة للكون كثنائية الأضاد وتعاقبها، أو ثنائية عالم المثل وعالم المحسوسات
تقوم الثنائية على فكرة أن ثمة قدرة على الربط بين الظواهر التي يبدو أنها منفصلة، فالتضاد رابطة مثل التماثل، والتناقض رابطة، لأنه يعني نفي النقيض، فوجود النور ينفي وجود الظلام، والفساد ينفي وجود الصلاح. لذا يدخل الفساد مع الحكم الصالح في علاقة تناقض. فالحالتان المتضادتان إذا تتالتا أو اجتمعتا معاً عند الشخص المدرك نفسه كان شعوره بهما أتم وأوضح. وهذا لا ينطبق على الإحساسات والصور العقلية فقط بل ينطبق على جميع حالات الشعور كالتعب والراحة، كالألم والسعادة
وحتى يمكن إدراك القبح القبيح الكامن في الفساد فإن ذلك لا يتأتى في الإدراك إلاّ إذا تقابل الفساد مع الحكم الصالح. والتقابل هو علاقة بين شيئين أحدهما مواجه للآخر، كتقابل السلب والإيجاب، أو كتقابل السواد والبياض أو تقابل العمى والبصر، أو تقابل الصالح والفاسد.
ولأن طبيعة الدماغ البشري لا تقبل بالفصل بين المتقابلات/ المتناقضات، فحين تبدأ عملية التقابل/ التناقض في العقل البشري بالاشتغال فإنها تضع الطرف الأول في حالة تعارض وتناقض مع الطرف الثاني فوراً. الحكم الصالح في مواجهة الحكم الفاسد. الخير في مواجهة الشر. الضوء في مواجهة العتمة أو الظلمة، الظلم في مواجهة العدل.
وحتى يتضح المضمون القبيح والرديء والظالم والمشين لماهية الفساد، لا بدّ من الإشارة أو الانطلاق من القيمة المضادة للفساد وهي الحكم الصالح. ولكن هل يوجد حكم سياسي (نظام سياسي) دون دولة؟ وهل وجدت في التاريخ دولة دون عقد اجتماعي؟ وما هي القيم الكامنة في العقد الاجتماعي الذي أسس لمؤسسة الدولة؟ وما هي الدولة، وهل يمكن أن تكون هناك دولة دون نظام سياسي؟
وهل تكمن جذور الفساد السياسي في الدولة أم في النظام السياسي، وهل هناك وظائف مختلفة للدولة عن وظائف الحكومة؟ ولماذا تلتقي الشعوب على الدولة وتختلف على الحكومة؟ وهل كان البشر في مجتمعاتهم المختلفة بحاجة إلى الدولة؟ قد تكون هذه بعضاً من الإشكاليات التي تطرح نفسها بقوة عند “اللحظة المعرفية” التي تتوق للفهم المعمق لظاهرة الفساد
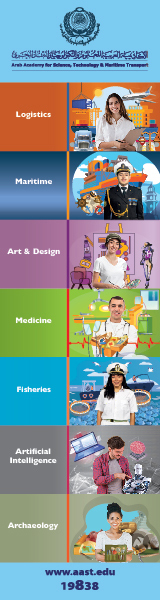
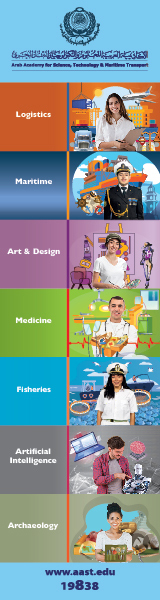
 جريدة هرم مصر حقيقه بدات
جريدة هرم مصر حقيقه بدات