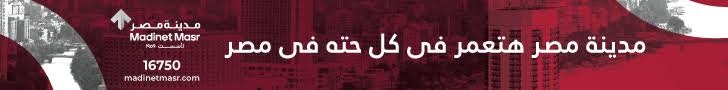كتب د/ عادل عامر
من معاني كلمةِ «فن»، في لسان العرب: الإبداعُ. وبتعبير ابن منظور: «رجلٌ مِفَن: يأتي بالعجائب» ومن العجائب ما يأتي على غير سابق مثال، وهو ما يسمونه الإبداع في لغة الفن المعاصر. ولهذه الكلمة معان أخرى كثيرة تردُ في قواميس اللغة العربية ومعاجمها القديمة، وهي -في أغلبها- تجعلُ كلمةَ «فن» مرادفة لمعنى «نوع».
وهي تشير أيضاً -في معنى متقدمٍ- إلى «القواعد الخاصة بحرفة أو بعملٍ أو بعلمٍ». أما في القواميس والمعاجم العربية الحديثة فقد اكتسبت كلمةُ «فنٍ» معاني جديدةً منها: ما ينتجه الفنان ليعبر به عن مُثلِ الجمالِ الأكمل. وثمة ثلاثة مداخل علمية كبرى للنظر في الفنون: الأولُ لغوي نقدي، والثاني عقلي منطقي يبحث في المواقف والاستجابات والاتجاهات المتعلقة بموضوع الجمال، والثالثُ فلسفيٌ تأمليٌ يبحثُ في موضوع الجمالِ ذاته وفي غائياته. وتغطي هذه المداخل في مجملها مسائل كثيرة من أهمها: العلاقة بين الشكل والمضمون، والاستجابة للجمال والاستمتاع به، والتمثيل والتعبير، وتذوق الفن ونقده والحكم عليه، وأثر الخبرة الجمالية على حياةِ الإنسان، ودور المحاكاة والخيال والعواطف في إبداع الفنون، والرمز في الفن…إلخ.
ولم أجد في المعاجم والقواميس اللغوية العربية القديمة تعريفاً اصطلاحياً لكلمة «فن». فالجرجاني صاحب «التعريفات» لم يضع لها تعريفاً اصطلاحياً، واستخدم كلمة أخرى عوضاً عنها هي: «الصناعة»، وعرفها بأنها «ملكةٌ نفسانيةٌ تصدرُ عنها الأفعالُ الاختياريةُ من غيرِ رويةٍ. وقيل هي: العلمُ المتعلقُ بكيفية العمل» ولكنه أتى بتعريف غاية في دقة التعبير وعمق النظر لكلمة «الجمال»؛ إذ هو، عنده، «من الصفات: ما يتعلق بالرضا واللطف»
أما في المعاجم الحديثة فكلمةُ «فن» لها معانٍ اصطلاحية متعددة تتلخص في «جملة الوسائل التي يستعملها الإِنسانُ لإِثارة المشاعر والعواطف وبخاصة عاطفة الجمال»، وهي «مهارة يحكمها الذوق والموهبة». وتغطي الفنونُ بمدلولاتها المعاصرة «كُلَّ الإِبْدَاعَاتِ الَّتِي تَرْتَقِي إِلَى الْكَمَالِ وَالْجَمَالِ، وَتَسْمُو بِالْخَيَالِ إِلَى َالإِبْدَاعِ كَالشِّعْرِ وَالْمُوسِيقَى وَالرَّسْمِ وَالنَّحْتِ وَالزُّخْرُفِ وَالْبِنَاءِ وَالرَّقْص، وأَجْنَاسُ الأَدَبِ من: الشِّعْرُ وَالْمَسْرَحُ وَالْقِصَّةُ وَالرِّوَايَةُ. وللفنون عامة عدةُ تصنيفات منها: «الفنون الجميلة»، و«الفنون التشكيلية»، و«الفنون التعبيرية»، و«الفنون التطبيقية، و«الفنون الأدائية»
وتكشف القراءةُ الجماليةُ للقرآن الكريم عن أن للفنونِ والجماليات بمختلف أنواعها أصولاً شرعية واردة في المرجعية القرآنية العليا. وأقتصر هنا على بيان الرؤية القرآنية لفن صناعة التماثيل؛ وهو الفن الأكثرُ إثارةً للجدل من حيث «الحل»، و«الحرمة». ففي القرآن نجد حديثاً عن التماثيل في مشْهَدَيْن: المشهد الأول خاص بسيدنا إبراهيم ڠ ففي شأنه ورد في سورة الأنبياء قولُه تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ.
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ. قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ]سورة الأنبياء: 51-59 [.والمشهد الثاني يخص سليمان ڠ في سورة سبأ. قال تعالى:﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِوَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 12-13].
وفي ضوء هذين المشهدين اللذَيْن حكاهما القرآن، يتضح أن التماثيل حرامٌ في الموقفِ الأول مع سيدنا إبراهيم، وحلال في الموقف الثاني من سيدنا سليمان؛ بل إن عملَها معه كان فضلاً من أفضال الله تعالى على آل داود يستحق الشكر. ولم يكن سليمانُ يهدفُ بطبيعة الحال أن يتخذَها أصناماً يعبدُها من دون الله.
وعلى أساس هذا التوجيه القرآني يمكنُ فهم الأحاديث النبوية المتعلقة بالتصوير وغيره من صيغ الفن والفنون الجميلة. فبعض ما رود في الأحاديث النبوية بشأن تحريم صناعة التصوير إنما كان يعني ما يصنع منها بقصد العبادة؛ أي صناعة الأصنام ويؤيد ذلك أن العمل الأساسي لصانع التصاوير في الجاهلية هو «صناعة الأصنام»
. وإذا كان الإسلام قد نهى عن عبادة التصاوير، إلا أنه لم يحظرْ صناعتها. ومن الأدلة على ذلك أن ابن عباس أباحَ لصانع التصاوير -الذي جاء ليستشيره في أمر صناعته- أن يصور فقط الشجر وكل ما ليس فيه روح» أي أنه أباحَ تصوير ما ليس له قدرة ظاهرة؛ حتى لا يظن المصور أنه قادر على الخلق، وحتى لا يزعم إنسانٌ أن الصورة لها قدرة، أو قوة، أو عمل؛ وبذلك تزول شبهة الرجوع إلى عبادة الأوثان والأصنام، ولا سيما أن القومَ كانوا حديثي عهد بتلك العبادة.
ويتبينُ باستقراءِ كثير من آيات القرآن الكريم، أن إبداعات الله سبحانه وتعالى تجمع بين النفعية والجمال والزينة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ﴾[الصافات:6]. وقوله سبحانه: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾[النحل:6]. وقوله:﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾[الكهف:7]. وقد عرض القرآن الكريم مجالات الجمال المتعددة ومنها الجمال الظاهري، كما في قوله تعالى:﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾[الأعراف:31]». ومنها الجمال المعنوي؛ الذي يتجلى في الصبر، والهجر، والصفح، والتسريح. قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾[المعارج:5]. وقال:﴿ واهجرهم هجراً جميلاً﴾[المزمل:10]. وقال: ﴿فاصفح الصفح الجميل﴾[الحجر:85]. وقال سبحانه: ﴿..وأسرحكن سراحاً جميلاً﴾ [الأحزاب:28].
وقد بذلتُ وسعي في حصر ما ورد في آيات القرآن الكريم من مفردات تعبر عن الجمال وفنونه، فوجدتها كثيرةً ومتنوعة وبالغة الثراء. ووجدت أن أوَّلها وواسطةَ عقدها هو: لفظ الجلالة «الله» بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وذاته التي لا يدركها كما هي إلا هو ذو الجلال والإكرام. ثم تأتي المفردات الأخرى ومنها: «الجنة»، و«جميل»، و«حسن»، و«الجلال»، و«زينة»، و«طهور»، و«مطهرة»، و«حور العين»، و«الزخرف»، و«التماثيل»، و«الآثار»، والألوان المختلفة، و«الخير». إضافة إلى الصور الجمالية الكونية والبيئية في الأرض وفي السماء، والتشبيهات التي رسمتها آيات كثيرة في عديد من سور الكتاب العزيز. وتحتاج هذه المفرداتُ إلى دراسة نصية ومقاصدية متعمقة في سياقاتها.
ومن هذا المنطلقِ القرآني تشكلت فلسفةُ فنان الحضارة الإسلامية. فغالباً ما استخدم فنه لخدمة غرض مشروعٍ، ولتحقيق مقصد من مقاصد الشريعة؛ مستعيناً بإضافة عناصر فنية تضفي على عمله الفني جمالاً في المظهر، وعمقاً في المعنى بما يدعم القيم الروحية، واضعاً نصب عينيه عقيدته التوحيدية الدينية. ولم يعرف هذا الفنان اللوحاتِ المستقلة كما عرفها الغربيون؛ حيث كان يرمزُ إلى الطبيعة، ولا يصورها؛ خشية تقليد خلق الله تعالى. واستخدم الرسوماتِ الزخرفيةَ المحتويةَ على عناصر نباتية وحيوانية بشكل محوري؛ بعيداً عن مشابهة خلق الله، ولم يحترم النسب الطبيعية، ولم يكنْ لعلم التشريح أي دورٍ في فنونه بخلاف الفنون الغربية. ولجأ أيضاً إلى التجريد بطريقة مختلفة عن فنون الحضارات الأخرى؛ فالتجريد في الفن الإسلامي عبارة عن رؤية روحية للأشياء؛ بمعنى رؤيتها في شكلها المعنوي، وليس في شكلها المادي.
وثمة سؤال تاريخي هنا هو: متى نشأت الفنونُ الجميلةُ في الإسلام؟. والأرجح في رأيي هو أن نشأتَها العمليةَ الأولى قد بدأت في العام الأول للهجرة النبوية من مكة إلى المدنية؛ حيث ظهر نموذجُها الأولُ في تخطيط مسجد قباء؛ وهو أول مسجد بناه الرسول ﷺ في المدينة المنورة. وكان نزولُه ﷺ أرضَ قباء في ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة، الموافق سبتمبر من سنة 622. ورغم ندرة المعلومات التي وصلتنا عن تفاصيل تصميم ذلك المسجد ومكوناته المعمارية؛ إلا أن المتوافرَ من تلك المعلومات يؤكد، في أغلبه، على أن البساطةَ والانتظامَ والانسجامَ بين عناصر المسجد المعماريةِ والوظيفية هي أوضحُ المعالم الجمالية الأولى التي تجلت في مسجد قباء، ومنه انتقلت تلك العناصر إلى بقية المساجد والعمائر الإسلامية الأخرى. ولم يمض وقت طويل حتى «اتخذ الفنُّ الإسلامي المعماري الجديد أهم أشكاله المميزة خلال العقدين الأخيرين من القرن الأول الهجري، وهما العقدان الأولان من القرن الثامن الميلادي. وأشهرُ الأمثلة على ذلك هو الجامع الأموي في دمشق»
وهو من آيات الفنون المعمارية الجميلة. ودخل «المسجدُ» في صلب التخطيط العمراني للمدن والأمصار؛ وأصبح لا يمكن تصور مدينة إسلامية إلا بوجود المسجد الجامع في وسطها. ثم تكاثرت الفنونُ المرتبطة بتصميم المساجد وتشييدها، وتطورت بمرور الزمن مع انتشار الإسلام ودخول أمم ذات حضارات عريقة فيه، ومنها حضارات: الصين، والهند، وفارس، وروما، واليونان ومن المهم التأكيد هنا على أن ازدهار الفنون الإسلامية الجميلة ترافق مع ازدهار الحضارة الإسلامية وقوتها. وشملت ما يعرف حديثا باسم «الفنون التطبيقية» وهي: العمارةُ (أو: «الريازة» بتعبير الأندلسيين)، والخزف، والزجاج، والمعادن، والنسيج، وما إلى ذلك من فنون تخدم غرضاً ما، أو تؤدي وظيفة معينة. وشملت أيضاً فنون العمارة: المدنية، والدينية، والحربية. وكان الفنان المسلم في أغلب أعماله يقوم بتوظيف مهاراته في خدمة المقاصد الشرعية؛ فبدلاً من أن يرسم صورة بغرض الإمتاع البصري وحده؛ كان يزخرف بها إناءه، أو يزين بها سيفه، أو سجادته؛ لتسهم في التذكير ببعض القيم الإيمانية الكبرى التي حضت عليها تعاليم الإسلام.
ودون الدخول في تفاصيل تاريخ الفنون التي عرفتها الحضارة الإسلامية في تاريخها الطويل؛ فإن مقتنيات المتاحف والمعارض المتخصصة في الفنون الإسلامية وآثارها شرقاً وغرباً، وشمالاً وجنوباً([10]) -وأحدثها هو متحف «السلام عليك أيها النبي»- كلُّها تشهدُ على أن الفنون الجميلة بمختلف أنواعها نالت حظاً وافراً من العناية والاهتمام من المسلمين، وأنها أيضاً قد انفتحت على مختلف الخبرات الحضارية وهذبتها واستوعبتها وأضافت إليها وصبغتها بطابعها الإسلامي الخاص. كما تدلنا تلك الآثار على أن «وجود الله» هو الأساس العقيدي الذي صبغ جل أعمال الفن الإسلامي، وكما يقول روجيه جارودي: « إن كلَّ غرض حتى ذلك الأكثر استعمالاً ؛ سواء كان سيفاً، أو إبريقاً، أو طبقاً من نحاس، أو سرجَ حصان، أو منبراً، أو محراباً في مسجد؛ هو محفور ومرصع أو مطروق ليشهد أنه علامة على وجود الله». وأضيفُ: وأنه علامة أيضاً على وحدانيته سبحانه وتعالى.
ورغم كثرة البحوث في قضايا الفنون الإسلامية ومشكلاتها النظرية والعملية؛ إلا أن السؤال عن علاقة هذه الفنون بالمقاصد العامة للشريعة، لم يحظ للساعة بما يستحقه من الدرس- والتأصيل. ولا تزالُ أغلبُ البحوث في الفنون الإسلامية معنية بالجوانب التاريخية، أو الفقهية (الحلال والحرام)، أو المعمارية والهندسية، أو بعلاقات التأثير والتأثر بين الفنون الإسلامية وغيرها من فنون الحضارات الأخرى. أو هي معنية بمسائل وموضوعات مفردة مثل: الرسم، أو التصوير، أو التمثيل، أو الشعر، أو الموسيقى، أو الغناء، أو الزخرفة والزركشة ؛ دون محاولة صوغِ نظريةٍ عامة ورؤية معرفية شاملة لها، واكتشاف علاقة كل هذه الفنون بالمقاصد العامة للشريعة. ومع هذا فإن «مادة» النظرية العامة للفنون وجمالياتها وعلاقتها بمقاصد الشريعة مبثوثة، ومتناثرة في اجتهادات قدماء العلماء وبعض محدثيهم.
قديمًا؛ تناولَ علماءُ المسلمين الفنونَ الجميلة ومسائلَها بقدر كبير من التوسع مع التعمق الفلسفي. فالمعتزلة مثلاً ربطوا الأخلاق والجمال بالعقل وبالشرع معاً؛ وذهبوا إلى أن ما حَسُنَ في نظر العقل يكون حسناً في نظر الشرع. وابن سينا (370-428ھ /980-1037م) رأى أن «جمالَ الشيء وبهاءه هو أن يكون على ما يجب له»([13]). وابن طفيل كتب رسالة في «فن الموسيقى» استعاد فيها النظرية الكلاسيكية حول التوافق بين أجناس الألحان والأمزجة البشرية؛ وأكد على الامتدادات التربوية والتطبيقية لهذا التوافق؛ بما في ذلك التطبيقات الطبية عنده
أما الإمام الغزالي فقد سبق غيرَه من من قدماء العلماء في التأصيل للنظريةِ العامة في الفن والفنون الجميلةِ الإسلامية، وتلاه آخرون منهم ابن قيم الجوزية.
قسَّم الغزالي الجمالَ إلى «جمال الصورة الظاهرة المدركة بعين الرأس، وجمال الصورة الباطنة المدركة بعين القلب ونور البصيرة» ووظف مفهوم الجمال في شرح أسرار المحبة الواجبة بين العبد وربه، وهي محبة مبنية على جبلِّية الانجذاب البشري للجمال وفطريته، وهو«حبُّ كلِّ جميلٍ لذاتِ الجمال، لا لحظ ينال من وراء إدراك الجمال؛ فذلك مجبول في الطباع»
وشرح الغزالي كيف أن الموسيقى أو فن «السماع» «يثمر حالة في القلب تسمى الوجدَ، وأن الوجدَ يؤدي إلى تحريك الأطراف بحركات غير موزونة تسمى اضطرابا، أو بحركات موزونة تسمى التصفيقَ والرقص. وأكد على أن كل سماع يتم عن طريق قوةِ إدراك. وأن قوى الإدراك الحسية هي الحواس الخمس… وأما القوى الباطنة فمنها قوة العقل وقوة القلب، وكل قوة من هذه القوى تلذذ بموضوعها إذا استحق هذا الموضوع هذا الشعور باللذة
ويرجع الإمام الغزالي كل ألوان الجمال والخير إلى الله تعالى المتصف بصفات الجمال والجلال فيقول: « لا خير ولا جمال ولا محبوب في العالم إلا وهو حسنة من حسنات الله، وأثر من آثار كرمه، وغرفة من بحر جوده؛ سواء أُدرك هذا الجمال بالعقول، أو بالحواس. وجماله تعالى لا يتصور له ثان، لا في الإمكان ولا في الوجود»أما ابن قيم الجوزية فيبدأُ تأصيلَه للفنون والجماليات بحديث النبي ﷺ «إن الله جميل يحب الجمال» ويبين أن المطلوبَ هو جمال الظاهر والباطن. ثم يربط المعرفة بالجمال بالإيمان فيقول: «إن من أعز أنواعِ المعرفة؛ معرفة الرب سبحانه بالجمال»
. وخلاصة ما ذهب إليه هو أن معرفةَ الله تكون ميسورة وقليلة الأعباء على من سلك طريق الذوق الجمالي، وأن عبادة الله تعالى يجب أن تكتسي لونا جمالياً شفافاً في العقيدة والشريعة والسلوك، وعلى المؤمن أن يكشف تجليات الجمال العقيدية والتشريعية والسلوكية ليستمتع بتطبيقها، وهو يعبد الله ويعرفه «بالجمال الذي هو وصفه، وبالجمال الذي هو شرعه ودينه»
ومن مثل تلك الرؤى الكلامية والفلسفية (لابن سينا والكندي والفارابي، مثلاً، إسهامات عميقة الغور في هذا الموضوع لا يتسع المجال الذكرها) ومن الاجتهادات الأصولية والمقاصدية للفنون والجماليات الكونية والنفسية؛ نستنتج أن قدماء علماء المسلمين قد أدركوا عمقَ علاقة الفنون بمقاصد الشريعة، ولكنهم لم يضعوها في صياغات مباشرة في علاقتها بكلياتها ومقاصدها العامة؛ وخاصة المقاصد والكليات الكبرى: الدين، والعقل، والنفس، والعدالة، والحرية.
ومقتضى كلامهم أن التأملَ في الجماليات مؤدٍ حتماً إلى الإقرار بوحدانية الله تعالى، وإلى الاتزان العقلي، والهدوء النفسي؛ على مستوى الأفراد والجماعات. ومن ثم يسهم الاهتمام بتلك الجماليات وفنونها في تهيئة الذهن والقلب للإيمان بالله وتوحيده، وفي بناء العمران والتمدن، وفي تقوية ما نسميه «الصحة العامة»، و«السلم الأهلي» وفق مصطلحاتنا المعاصرة.
أما حديثاً؛ فبحوثُ العلماءِ في موضوع الفنون الجميلة كثيرة جداً باللغة العربية وبغيرها، ولكن قليل منها يبحث في علاقتها بمقاصد الشريعة؛ بل نادر جداً، ومنها مثلاً: كتاب الدكتور محمد عمارة «الإسلام والفنون الجميلة». وكتاب الرئيس على عزت بيجوفتش «الإسلام بين الشرق والغرب».
فالدكتور عمارة بيَّن في كتابه أن الفنون يجب أن تكون جميلةً في ذاتها، وجميلةً في تأثيراتها ووظائفها ومقاصدها، وأن «فنون الدَّعة والبطالة والتواكل والاسترخاء والسطحية والتفاهة، غير فنون الحمية والعمل والعزم والانتماء والنهوض». وهو يرى أن «الفن الجميل… مهارة يحكمها الذوق الجميل والمواهب الرشيدة؛… لإثارة المشاعر والعواطف». وذهب الدكتور عمارة إلى أن خروجَ المهارات والفنون عن المقاصد الرشيدة يجردها من شرف الاتصاف بالجمالِ»، واستشهد على ذلك بقول ابن سينا الذي أوردناه قبل قليل وهو أن «جمال كل شيء وبهاءه هو أن يكون على ما يجب له». وينتهي الدكتور عمارة إلى أن الفن المتسق مع الإسلام هو الذي يحقق مقاصدَه في أمته، وفي الإنسانية؛ عندما تشيع فيه الصبغة التي صبغت بها عقيدته، وميزت بها أيديولوجيته إبداع الإنسان الفنان، إنها خيوط غير مرئية تلك التي تربط الوضع الإلهي بالإبداع الإنساني الجميل»
أما الرئيس علي عزت بيجوفتش، فقد رسم معالم نظرية إسلامية في الفنون من منظور إسلامي وبرؤية مقاصدية وفلسفية عميقة. وذهب إلى أن وجودَ عالم آخر ونظام آخر إلى جانب عالم الطبيعة هو المصدر الأساسي لكل دين وفن؛ فإذا لم يكن هناك سوى عالم واحد لكان الفن مستحيلاً. وهو يعتبر العمل الفني من حيث هو إبداع «ثمرة للروح». وبينما يكون المطلوب في العلم أن يكون دقيقاً؛ فإن المطلوب في الفن هو أن يكون صادقاً؛ لأنه يعكس النظام الكوني دون أن يستفسر عنه إن ما ذهب إليه قدماءُ العلماء مثل الغزالي وابن قيم الجوزية، ومحْدثوهم مثل الدكتور عمارة والرئيس بيجوفيتش، بشأن التأصيل النظري والفلسفي للفنون والجماليات، لا يزال -رغم أهميته- غير كاف لصوغ «نظرية عامة» للفنون والجماليات وفق معايير المرجعية الإسلامية. وهنا يكمن أحد أهم وجوه إشكالية العلاقة بين الفن والفنون الجميلة وبين المقاصد العامة للشريعة: إنه النقص في الكتابة التأصيلية للنظرية العامة، والاكتفاء ببعض الجزئيات والاجتهاداتِ الفرعية، دون الوصول إلى رؤيةٍ معرفية شاملة تغطي الجوانب المختلفة للفنون والجماليات، وتجيب على الأسئلة الفلسفية الكبرى التي يثيرها موضوع الفن والجمال في حياة الإنسان الدنيوية والأخروية.
من المفيد في سياقِ السعي لحل هذه الإشكالية أن ننفتحَ على نظريات المدارس الغربية الحديثة في مجال الفنون الجميلة من حيث فلسفتها ووظائفها وأنماطها المختلفة؛ فهي بالغةُ الثراء، وفيها ما لا يجافي الرؤية الإسلامية ويتفق معها حيناً، كما أن فيها ما يجافيها ويتناقضُ معها أحياناً. ولا يصح أن نتجاهل «جماليات» الرؤية الغربية ومقاصدها بحجة أن لها قبائح؛ مثلما لا يصح أن نتهاون بشأن قبائحها بحجة أن لها جماليات.
هناك من علماءِ الغربِ وفلاسفتِه المعاصرين من ذهب إلى أن الشيء الجميل هو ناتج الممارسة الاجتماعية التاريخية. ويعتبر الفيلسوف «هيجل» من أشهر القائلين بذلك. وهناك من لاحظ –بحق- أن ظاهرة الانسجام؛ وهي أساس الشعور بالجمال، وكذلك «عدم الانسجام»، الذي هو أساس الشعور بالقبح؛ ترجعان إلى تاريخ طويل في حياة الإنسان. ومنهم من ركز على علاقة الفن بالحياة، وبالدين، وبالعلم؛ وخلصوا إلى أن الفن أداة ربط اجتماعي، ووسيلة تطهير للنفس الإنسانية، وضمانة للتماسكِ والتجانس بين أبناء المجتمع الواحد. وهناك علماء وفلاسفة آخرون ربطوا بين الجمال والأخلاق ونبهوا إلى الدور التربوي لكليهما، بل وأقاموا علاقة وثيقة بين «الخير ـ والحق ـ والجمال»
. ومن هؤلاء مثلاً الأديب الروسي بلنسكي (1811ــ 1848م) الذي قال: «إن الجمال شقيق الأخلاق. والصور الفنية الإيجابية التي تعكس حياة الناس ونبلها وجمالها تفرض الاحترامَ والحبَّ والإعجابَ المخلص. وتعطي أنماط الأبطال الحقيقيين في الحياة للقارئ والمتفرج متعةً وبهجةً جماليتين. أما الصور السلبية فهي تثير مشاعر الاستنكار الأخلاقي، والاحتقار التي ترتبط ارتباطًا وثيقا في طابعها بمشاعر الازدراء والاحتقار التي نحسها عندما ندرك ما هو قبيح ودنيء. ومن ثم فإن وحدة الجمالي والأخلاقي هي أساس الدور التربوي ودور التحويل الأيديولوجي اللَّذَيْن تقوم بهما الفنون في الحياة الاجتماعية» للفنون ـ إذن ـ مهماتٌ لا غنى عنها في كل حضارة من الحضارات؛
وإن اختلفت مرجعياتها الفلسفية، أو تباينت مقاصدها وغاياتها النهائية. وتكاد أغلبُ الرؤى الحضارية والفلسفية تشترك في أن أهم مقاصد الفنون تتمثل في: تنمية العاطفة والوجدان، وتنمية مهارات الحواس وتدريبها على الإجادة والإتقان، وتعزيز الشعور بالهوية الذاتية، وحفز الإنسان على الإبداع والابتكار وتأكيدِ الذات، وضبط الانفعالات وترويض النزعات الجامحة ووضعها في حالة اتزان، وتقدير العمل اليدوي ومهارات الصناعة، وفتح المجال أمام الخيال واستثماره في خدمة الإنسان والعمران. ووحدها؛ تربط الفلسفة الإسلامية الجمال وفنونه بعقيدة توحيد الله سبحانه وتعالى؛ فهي في مجملها: تدل عليه، وتهدي إليه.
ورغم نبل تلك الغايات؛ إلا أن الفنونَ لم تسلم من سوء الاستخدام لتأجيجِ الصراعات الدينية والمذهبية، وتحقيق مآرب اقتصادية وسياسية على حساب الغير؛ حتى إن بعض الحركات ذات «النزعة الإنسانية» العالمية لا تخفي رغبتها في استبدال الفن بالدين. وفي سبيلِ ذلك تقوم تلك الحركات بتوظيف المعارض الفنية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، والأعمال المسرحية والغنائية، ومختلف الفنون التشكيلية من أجل إزاحة منظومات القيم المستمدة من المرجعيات الدينيةِ -وأولها المرجعية الإسلامية- ووضع منظومات جديدة مكانها تكون مستمدة من مرجعيات إنسانية أو وضعية فحسب. وهذه ظاهرة يتعين التعامل معها ومواجهتها بأدوات من جنس أدواتها؛ بشرط أن تكونَ بنفس درجة الإحكام والإتقان والمهارة والاحتراف.
وإذا كانت الفنون الإسلاميةُ تشتركُ مع غيرها من الفنون في أغلب تلك الغايات، إلا إنها تظلُّ مرتبطةً بتصور الوجود من خلال تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان والخالق سبحانه وتعالى. ووفق هذا التصور فإن الفنونَ الإسلامية ترسم صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود وخالقه الواحد سبحانه وتعالى. ولهذا اتسع نطاق عمل الفنون الجميلة في حضارتنا الإسلامية. ولحضارتنا سوابق بارعة الجمال في: النقش والنحت، والرسم والزخرفة، والتصوير والحفر، والموسيقى والشعر، والغناء، والخط، والمنمنمات، وأيضاً في ألوان مختلفة من الرياضة، وفي أصول تنظيم المدن والأمصار وتخطيطها، وهندسة البناء،..إلخ.
ومن الأمثلة على ذلك: ما سجلته كتب أصول البنيان والخطط العمرانية للأمصار والمدن الإسلامية حيث يرد التشديد على ضرورة توافر الجوانب الجمالية، والتأكيد على وجوب مراعاة معايير الجودة في التخطيط وهندسة البناء. وتحظى جماليات «المجال العام» من السقايات، والفوارات (الشاذروانات)، والمفترجات، والميادين الرحبة، والأشجار الوارفة…إلخ، باهتمام كبير أيضاً. وقد أوصى كُتَّاب الحكمة السياسية بمراعاة المقاييس الجمالية في الجوانب المعمارية عند إنشاءِ الأمصار، ومن ذلك الشروط التي ذكرها الماوردي في كتابه «تسهيل النظر» ومنها : «سعةُ المياه المستعذبة»، وإمكانُ الميرةِ المستمدة، واعتدالُ المكان الموافق لصحة الهوى والتربة، وقرب المكان مما تدعو إليه الحاجة من المراعي والأحطاب، وتحصين المنازل من الأعداء
إن مراعاة معايير الجمال في تأسيس المدن كان تعبيراً عن تفكيرٍ مقاصدي من الطراز الأول؛ حيث رأى أولئك العلماء أنه لا غنى عن تلك الجماليات لضمان الصحة النفسية والاتزان العقلي لسكان المدينة؛ فالمشاهدُ المبهجة، والألوان المتناسقة، والمساحات الخضراء، والزهور المفرحة، والنظافة العامة؛ كلها تؤثر إيجابياً على المزاج النفسي العام؛ بخلاف مشاهد القبح والفوضى والقذارة والعشوائية التي تضر بالصحة النفسية وتشجع على العنف، ومن ثم تسهم في إلحاق الأذى بالنفس، والمال، والنسل، والعقل، والدين في آن واحد.
إن أحوالَ أغلب مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة تشيرُ إلى ضعف ما يقدمه مبدعو الفنون الجميلة في هذا المجال العام العمراني. وتكشفُ المشاهدات المباشرة في هذا الواقع عن قلة الابتكار، وتؤكد التبعية لمدارس الفنونِ الغربية. وقد أضافت إليها سلوكيات التخلف مزيداً من السلبيات، ومنها: ازدواجية الجمال والقبح؛ فالجمال داخل البيوت، أو في أغلبها، والقبح في الشوارع، أو في أغلبها. والكل متعايش مع الكل ويساكنه!.
وقد أسهمتْ بعض الرؤى السلفية المتشددة في تكريس هذه الحالة، مثلما أسهمت بعض الرؤى المتغربة في ذلك أيضاً. وكانت النتيجة هي شيوع التشوه في الوعي، والتمزق في الوجدان، والاختلال في عمليات التنشئة على المستويات الفردية والجماعية. ومن ثم تكونت، في التاريخ الحديث والمعاصر لأغلب مجتمعات الأمة، أجيالٌ مجروحة الهوية. وتكفي الإشارة هنا إلى أن ثلاثةَ آلافِ مدرسة أجنبية نشأت في أرجاء الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر، واستمرت إلى أن ألغيت الخلافة في سنة 1924م؛ وكانت تلك المدارس كفيلة بتكوين نخبة منفصلة عن هويتها؛ نتيجة ما تلقته من مقررات تربوية وفنية وأدبية تنتمي لتراث فلسفي وحضاري له مقاصدُ وغايات لا تنسجم بالضرورة مع غايات المجتمعات الإسلامية ولا مع مقاصدها العامة.
ولعل أهمَّ ما يكشف عنه التاريخ الحديث والمعاصر للفنون في مجتمعات الأمة الإسلامية هو أنها أصبحت في خدمة عمليات إعادة تشكيل الوجدان الفردي والجماعي وفق رغبات المستبدين والطغاة؛ وبعيداً عن المرجعية الإسلامية ومقاصدها العامة. ونعتقد أن «الفنون الحديثة» في بلادنا بجملتها قد أسهمت في تعميق حالةَ الانقسام الثقافي بين اتجاهات متعارضة؛ بعضها يتمسك بهويته الأصيلة، وبعضها ينفتح على هويات وثقافات أخرى وافدة، ويحلها محل الهوية الأصيلة. وكان من نتائج ذلك أن مجتمعاتنا تعيش سيناريوهات سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية ليست فاعلة فيها ولا منتمية وجدانياً إليها؛ بل كانت في أغلب الأحوال مادة استعمالية لها.
وبمرورِ الوقت زادت التحدياتُ التي تواجهُ مبدعي الفنون الجميلة الإسلامية؛ وزاد انفصالها عن استلهام مقاصد الشريعة، وزاد ابتعادها عن خدمة هذه المقاصد. وعليه فإن الذي يتصدى للإبداع الفني والجمالي بمرجعية إسلامية يحتاجُ إلى تأهيل رفيع المستوى، وحرفية بارعة، ورؤية فنية رسالية واسعة الأفق تستجيب لمقاصد الشريعة وتكون في خدمتها؛ على النحو الذي كان عليه أسلافه من مبدعي الفنون الجميلة في عصور الازدهار الحضاري الإسلامي.
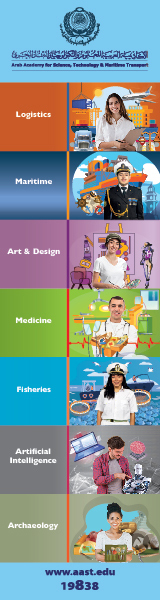
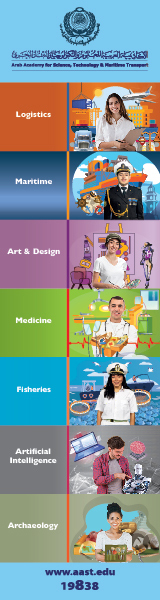
 جريدة هرم مصر حقيقه بدات
جريدة هرم مصر حقيقه بدات