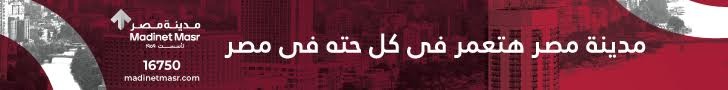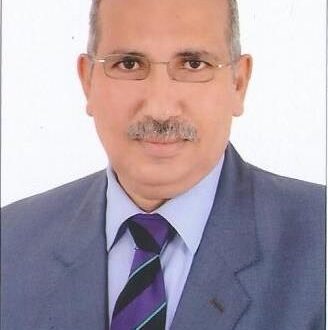كتب /الدكتور عادل عامر
حرص دستور مصر لعام 2014 على كفالة حق الترشيح وتمكين المواطنين من ممارسته، ليضمن إسهامهم باختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة السلطة، ورعاية مصالح المجتمع، وتتسم كفالته لهذا الحق بممارسته ممارسة جدية وفعالة، لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستورياً، ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية، ومعبرة تعبيراً صادقاً عنها.
وقد أورد الدستور في المادة (102) منه العديد من الشروط صراحة، منها اشتراط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب مصرياً، وحاصلاً على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأحال في الوقت ذاته الى القانون تنظيم شروط الترشيح الأخرى، بالزام المشرع أن يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين. عليه سنقوم بتقسيم المطلب إلى ثلاث فروع سنتناول في الفرع الأول شرط التمتع بالجنسية المصرية، وفي الفرع الثاني سنتناول شرط المؤهل العلمي، أما في الفرع الثالث سنتناول شرط من الترشيح كالاتي :
الفرع الأول : التمتع بالجنسية المصرية
تعرف الجنسية الأصلية بانها الجنسية التي تفرض على الشخص فور الميلاد، أما بسبب أصله الوطني، وهذا ما يسمى بمعيار أو أساس ( حق الدم)، أو بسبب مكان ميلاده ويطلق عليه معيار أو أساس (حق الإقليم)، أو على أساس الحقين معاً، وهي تثبت للشخص بحكم القانون دون حاجة الى تقديم طلب أو الحصول على موافقة من جهة معينة
وتفرق العديد من الدول في مجال ممارسة الأفراد لحقوقهم السياسية بين طائفتين ممن يحملون جنسيتها، إذ تمثل طائفة من يحمل جنسيتها بصفة أصلية، أي يكون من أصل شعبها، وهم المواطنون الأصليون، وطائفة من يحمل جنسيتها بالاكتساب وهم المواطنون بالتجنس، وهم مواطنون الدولة الذين يحصلون على جنسيتها بالاكتساب لا بالأصل.
ولقد استقرت غالبية الأنظمة السياسية على قصر ممارسة معظم الحقوق السياسية وفي مقدمتها حق الترشيح على مواطنيها الأصليين، وتقييد مباشرتها بالنسبة إلى المتجنسين بجنسيتها باشتراط قوات مدة معينة، وذلك للتحقق من توافر القدر المتيقن من الانتماء والولاء.
وتعتبر الجنسية من أهم الشروط القانونية لمباشرة الحقوق السياسية، فالجنسية تعتبر صفة في الشخص تقوم على رابطة سياسية وقانونية بينه وبين الدولة ، لذا نجد أن المشرع الدستوري المصري قد اشترط في المادة (102) من دستور 2014 أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب مصري الجنسية، وهو الأمر الذي يدلل على اشتراط الجنسية الوطنية كشرط جوهري لممارسة حق الترشيح، وذلك للأهمية التي يحظى بها هذا الشرط، باعتباره الركن الأصيل لقيام الدولة ، فالفرد الذي يحمل جنسية دولة معينة يتمتع بحقوق وحريات لا يتمتع بها من لا يحملها.
كما يلاحظ بهذا الصدد أن المشرع في المادة أعلاه حرص أن يكون المرشح مصرياً، أي حاصلا على الجنسية المصرية فقط، دون تحديد فيما إذا كانت هذه الجنسية أصلية أم مكتسبة، كما انه لم يشترط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب من أبوين مصريين، كما هو الحال قبل صدور دستور 2014، إذ كان المشرع يشترط في المرشح للنيابة أن يكون مصري الجنسية ومن أب مصري تحديداً، لكن وفق صياغة المادة (102) من الدستور الحالي فإنه لم يحدد ذلك في المرشح لعضوية مجلس النواب، على الرغم من اشتراط ذلك عند ترشيح رئيس الجمهورية، بلزوم أن يكون من أبوين مصريين تحديداً، وألا يكون قد حمل هو وأي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى ، كما اشترط ذلك أيضا في تعيين رئيس مجلس الوزراء .
وبعبارة أخرى فإنه في الوقت الذي قصر الترشيح لمنصب كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من المصريين الذين يحملون الجنسية الأصلية فقط، نجد بالمقابل ان المشرع الدستوري ساوى بين المصريين الذين يحملون الجنسية الأصلية أو المكتسبة بعد مرور (10) سنوات من إمكانية الترشيح لعضوية مجلس النواب.
وفضلاً عن ذلك فقد كفل الدستور في المادة (6) منه حق الفرد في الجنسية لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية والاعتراف القانوني به بمنحه أوراق رسمية، وهو الأمر الذي يمكن معه القول إنه تبنى ما سبقه اليه قانون الجنسية المصري رقم (26) لسنة 1975 عند تعديله بالقانون رقم (154) لسنة 2004، إذ اعتبر في المادة (2)(9) و (3) (10) منه بان من ولد لأم مصرية مصرياً أصيلاً.
وبهذا الصدد يثار تساؤل عن أحقية الأجنبي حامل الجنسية المصرية المكتسبة في الترشح لمجلس النواب؟
أن الإجابة على التساؤل المذكور توجب الرجوع الى المادة (102) من الدستور، وقد أسلفنا اشتراطها في المرشح تمتعه بالجنسية المصرية، دون تحديد نوع الجنسية التي توضح مصريته سواء أكانت أصلية أم مكتسبة، أي أنها جاءت بصورة مطلقة، ومن ثم يفهم من ذلك ان مكتسب الجنسية المصرية يعد مصرياً، ويتساوى مع المصري حامل الجنسية الأصلية بعد مرور فترة الاختبار الا ما استثناه المشرع بنص، ليكون مواطناً يتساوى مع غيره استناداً للمبادئ الدستورية في المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور (11)، وبهذا يتضح ان الصائغ الدستوري المصري كان واضحاً في عدم النص على قصر الترشيح على المرشح من أبوين مصريين تحديداً، ولو كان هذا ما يبغيه لكان حريصاً في النص عليه، كما هو الحال في اشتراطه ذلك عند ايراده شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه بالرجوع الى قانون الجنسية وتحديداً الى المادة (9)(12) منه فانه أصبح للمتجنس الحق في التمتع بمباشرة حق الانتخاب بمضي خمس سنوات من تاريخ اكتسابه الجنسية المصرية، والتمتع بحق الترشيح بمضي عشر سنوات من تاريخ اكتساب المتجنس الجنسية المصرية ليحق له ان يكون عضواً في مجلس النواب،
مع الاشارة الى وجود حالات اعفاء من مطالبة المتجنس بمضي فترة الاختبار أو التجربة، إذ جعلها القانون متروكة لسلطة رئيس الجمهورية دون شرط، أما بالنسبة الى سلطة وزير الداخلية فلقد اشترط ان يكون طالب التجنيس قد انضم إلى القوات المصرية وحارب في صفوفها. نخلص مما تقدم الى أحقية مكتسب الجنسية المصرية في الترشيح لعضوية مجلس النواب بمرور عشر سنوات من تاريخ اكتسابه الجنسية المصرية عند عدم وجود مانع آخر يمنعه من الترشيح. أما بالنسبة الى مزدوج الجنسية فمن استقراء المادة (102) من الدستور، نجد انها اشترطت أن يكون المرشح مصرياً فقط، ويكون المرشح مصرياً عند حيازته الجنسية المصرية، وبما ان هذه المادة قد أوردت الشروط الرئيسية والجوهرية التي يتوجب توافرها في المرشح ومنها الشرط المتقدم، فانه لا يمكن للمشرع العادي الخروج عليها، سواء بتقييدها أو بالانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها طبقاً لما نصت عليه المادة (92)(13) من الدستور، ومن بين هذه الشروط حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أي قيد أو شرط.
ولم يقتصر المشرع الدستوري على ما تقدم بل نجد انه أحال الى القانون تنظيم الشروط الأخرى التي يجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب، وفعلاً صدر قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة (2014)(14)، ليعيد تنظيم الشروط التي نظمها المشرع الدستوري بإضافة شروط أخرى، مع ان المشرع لم يطلب منه إعادة تنظيمها (15)، إذ نص في المادة (8/1) على انه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب : 1- أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة..”، ويتضح من هذا النص اشتراط ان يكون المرشح لعضوية مجلس النواب من أبوين مصريين، وبذلك منع مكتسب الجنسية من الترشيح، كما منع المواطن المصري الحاصل على جنسية أخرى الى جانب جنسيته المصرية من الترشيح أيضاً.
ونتيجة لذلك تم الطعن بذلك لدى المحكمة الدستورية العليا بالقضية رقم (24 لسنة 37 قضائية دستورية)(16) في (2015/2/12) التي يطلب فيها المدعي الحكم بعدم دستورية البند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة (2014) وبالتحديد نص متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة”. وصدر القرار في 2015/3/7 الذي اختزلت فيه المحكمة الدستورية العليا خلافاً قانونياً وفقهياً وقضائياً امتد لأكثر من خمسة عشر سنة، ومما جاء في قرارها بأن ” المشرع الدستوري أورد الشروط الرئيسية والجوهرية التي يجب توافرها في المرشح بحيث لا يجوز للمشرع العادي الخروج عليها، سواء بتقييدها أو بالانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها، ومن بين هذه الشروط حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أي قيد أو شرط خلافاً لما قرره نص المادة (141) من الدستور من أنه يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه، أو زوجه جنسية دولة أخرى”.
“فمن ثم كان على المشرع العادي الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعية وبمراعاة مراتب التدرج التشريعي، فإذا ما خرج عنه وأحل نفسه موضع المشرع الدستوري وأضاف للنص المطعون فيه قيداً وشرطاً جديداً بالانفراد بالجنسية المصرية، فانه يكون قد انطوى على مخالفة لنصوص المواد (87)(17) و (88) و (102) من الدستور، مما يستوجب القضاء بعدم دستوريته”.
ونتيجة لقرار المحكمة بعدم دستورية البند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الحالي، تم تعديله بالقانون رقم (92) لسنة 2015 (18) ليصبح نصها 1- أن يكون مصرياً ” بعد إن كانت قبل التعديل “1 – أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة “.
نخلص مما تقدم انه يشترط فيمن يرغب بالترشيح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً فقط، على أساس عمومية النص الدستوري وإيراده على سبيل الأطلاق، وعدم وجود قيد يحول دون ذلك، ويثبت ذلك من خلال حيازته للجنسية المصرية، ولا يمنع ذلك من ترشيح المصريين مزدوجي الجنسية أي الحاصلين على جنسية أخرى الى جانب جنسيتهم الأصلية، كما لا يمنع الأجنبي مكتسب الجنسية المصرية من الترشيح لعضوية مجلس النواب بعد مرور عشر سنوات على تاريخ تجنسه بالجنسية المصرية طبقاً للمادة (9) من قانون الجنسية رقم (26) لسنة 1975.
الفرع الثاني: المؤهل العلمي
في الوقت الذي اتجهت فيه غالبية الدساتير والقوانين الانتخابية إلى اعتبار شرط الكفاءة العلمية أحد القيود الواردة على مبدأ حرية الترشيح بصفة عامة ، نجد بالمقابل خلو دساتير وقوانين بعض الدول من النص على اشتراط الكفاءة العلمية فيمن يرشح لعضوية المجالس التشريعية كالدستور الفرنسي والأمريكي، فيما رفضت أخرى أن يكون هناك تمييزاً بين المرشحين لعضوية البرلمان بسبب الكفاءة العلمية كالدستور الياباني لعام 1947(20) ، ويرجع ذلك إلى أن هذه المجتمعات قد وصلت إلى مرحلة من التقدم يستحيل معها أن يختار الناخب سوى مرشحاً تتوافر فيه الكفاءة العلمية، أما البعض الآخر من هذه الدساتير فقد اشترط صراحة الكفاءة العلمية في المرشح لعضوية المجالس النيابية وأهمها إجادة القراءة والكتابة.
وبالرجوع إلى دستور عام 2014 نجد أن المادة (102) منه لم تشترط مستوى علمي معين فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب سوى أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، ومن ثم يتضح إن النص الدستوري اكتفى بشهادة التعليم الأساسي لمن يروم الترشيح لعضوية مجلس النواب.
ومن هذا المنطلق فإن اشتراط مستوى علمي معين في المرشح لعضوية مجلس النواب نصت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة في مصر وآخرها الدستور الحالي، وتنبع أهمية وقيمة هذا الشرط وضرورته في الطبيعة الشائكة للوظيفة التشريعية ، فهي – ويحق- أرقى الوظائف قاطبة والتي تتطلب في الأقل أن يكون عضو البرلمان الذي تعهد اليه مهمة التشريع قادراً على قراءة هذا التشريع وفهمه حتى يستطيع أن يناقشه، ناهيك عن دوره في رقابة الحكومة، وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد جرت أحكام مجلس الدولة على التأكيد على أهمية وجوب هذا الشرط ورتبت على تخلفه عدم صلاحية المرشح. ومن الجدير بالذكر احتدام الجدل والآراء المختلفة بين الفقهاء المصريين بشأن المستوى الدراسي الذي يجب اشتراطه في المرشح لعضوية مجلس النواب، والذي أدى بالنتيجة إلى اشتراط حصول المرشح على شهادة التعليم الأساسي بدلاً من مجرد القراءة والكتابة.
فقد كان البعض منهم يرى ضرورة حصول المرشح على مؤهل علمي عالٍ أو درجة ثقافية قانونية كدلالة على المعرفة والفكر تعينه على أداء مهامه التشريعية والرقابية بالاستناد إلى إن الدول منذ بداية القرن التاسع عشر تشترط قوانينها في الشخص الذي يتقدم لشغل وظيفة عامة مؤهلاً علمياً معيناً
. بينما يرى البعض الآخر إلى عدم ضرورة اشتراط نصاب علمي معين في المرشح، على اعتبار أن القاعدة العريضة من أعضاء هيئة الناخبين بل ومن المواطنين ناخبين أو غير ناخبين من الأميين الذين لاحظ لهم من التعلم في شيء، كما أن المهام القانونية والفنية التشريعية يوكل أمرها إلى لجنة متخصصة لكي تدلي بدلوها قبل التصويت بالموافقة أو الرفض عليها من جميع أعضاء المجلس. بينما يرى آخرون ضرورة أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل علمي معين، يمكن أن يكتفى بشأنه بالحصول على شهادة إتمام الدراسة للمرحلة الأولى من التعليم الأساسي (الإعدادية) أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى للمؤهل العلمي، إذ يعد وجود هذا المؤهل قرينة على قدر معقول من الثقافة القانونية لدى المرشح تساعده على أداء مهام وظيفته بالمجلس على نحو سليم يتفق والصالح العام.
ونتيجة للآراء المطالبة برفع المستوى العلمي للمرشح لعضوية مجلس النواب، فقد اشترط الصائغ الدستوري المصري في المادة (102) من الدستور الحالي أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، بعد أن كان يكتفي بإجادة المرشح القراءة والكتابة فقط في التشريعات السابقة. والذي نتج عنه دخول بعض الأميين إلى مجلس الشعب (سابقاً).
الفرع الثالث: سن الترشيح
تشترط جميعا أنظمة الانتخاب بلوغ المواطن سناً معينة، حتى يستطيع ممارسة حقه في الترشيح لعضوية المجالس النيابية، ويعد هذا الشرط مظهراً من مظاهر التشدد التشريعي حيال تحديد الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية المجالس النيابية، وبلوغ السن المطلوبة للترشيح، قرينة على نضج المواطن وقدرته على إدراك الأمور العامة، والقدرة على التصرف في تعقل وحكمه. وبالتالي يعدُّ شرط السن شرطاً أساسياً حتى يتمتع المرشح بالنضج اللازم لتمثيل الشعب في النيابة عنه ،
ويشترط عادة فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب سن أكبر من سن الناخب حتى يكون أكثر خبرة ونضوجا ، وعلى الرغم من تباين الأحكام الدستورية في الدول المقارنة في تحديد هذه السن إلا انه غالبا ما تم تحديدها بـ(30) عاماً أو عاماً، في حين اتجهت دول أخرى إلى ترك تحديد سن المرشح إلى القوانين الانتخابية. ففي مصر حدد المشرع الدستوري هذه السن أو العمر بـ عاماً ميلادية، خلافاً لما كان عليه الحال في دستور 1971 الملغى الذي أحال تحديدها إلى القانون، والذي جعل من الترشيح (30) عاماً، والفارق الجوهري بين الدستورين يتمثل في أن المشرع الدستوري في دستور عام 2014 النافذ حال دون إمكانية تعديل من الترشيح إلا بأتباع إجراءات تعديل الدستور نفسه.
ولقد كرر المشرع في البند (3) من المادة (8) من قانون مجلس النواب المصري رقم (46) لسنة (2014) ما نص عليه الدستور النافذ في مادته (102) من تحديد من الترشيح بخمس وعشرين عاماً. ويتمثل السبب في اتجاه المشرع الدستوري الى خفض سن الترشيح بعد قيام ثورة (25) يناير 2011 في إنه جاء استجابة لنداءات الثوار بخفض سن الترشيح لمجلس النواب إلى 25 سنة ميلادية لكي يضمن تمثيل الشباب في مجلس النواب.
ولقد تباينت آراء الباحثين بتخفيض سن الترشيح لعضوية مجلس النواب ورفعه بين مؤيد ومعارض ولكل منهم أسبابه ومسوغاته، فنادى المؤيدون بجعل من الانتخاب (25) سنة قبل صدور الدستور الحالي، وذلك لان تحديد السن اللازمة للعمل النيابي تتم بمراعاة السن المعتادة لبلوغ الخبرة اللازمة للنهوض به ومراجعة نجاعته بين فترة وأخرى ، كما أن السير في الاتجاه الديمقراطي الذي يوسع في نطاق المشاركة السياسية : يدعم هذا الرأي، ومن ثم يتوجب استكمال السير بتخفيض سن الترشيح للبرلمان. فيما يذهب أصحاب الرأي المعارض إلى ضرورة أن يكون من الترشيح (30) سنة، لأن تحديد سن المرشح بـ(25) سنة لا يتفق مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي ، ومن تم لا يكون المرشح قد بلغ من العمر سناً تمكنه من القيام بالمهام والأعباء التقيلة التي تتصل بإدارة الشؤون العامة في المجتمع، ولا يمكن قياس خفض سن الترشيح على سن التمتع بحق الانتخاب، على أساس الاختلاف الكبير في درجة المهام الملقاة على عائق النائب والناخب ونؤيد الرأي الأول بتحديد من الترشيح (25) لان المجالس النيابية بحاجة إلى الطاقات الشبابية لتجديدها، ولبلورة فرص جديدة لمشاركة الشباب في الحياة العامة، فضلاً عن المساهمة في توسيع قاعدة المشاركة بتنافس عدد أكبر من المرشحين.
أولا : أن الدستور المصري كان واضحا في تحديده لطبيعة المؤهل المطلوب عند الترشح أو التعيين لشغل المواقع القيادية والنيابية المختلفة، حيث حدده بشكل دقيق في بعض المواقع مقابل تركه لسلطة المشرع القانوني في مواقع أخري، فنجد أن المادة 102 قد نصت علي أنه بالنسبة لمجلس النواب ( يشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون … حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل) بينما نصت المادة ( 251 )
والمضافة في التعديلات الدستورية التي جري الاستفتاء عليها 2019 علي أنه بالنسبة لمجلس الشيوخ (يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون … حاصلا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل) بينما في المقابل خلت الاشتراطات الدستورية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية (مادة 141) وعضوية المجلس المحلية (مادة 180) أو للتعيين في مناصب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ( مادة 164 ) .
ثانيا : أن القوانين المنظمة للتنافسيات الانتخابية نصت وبشكل واضح علي تحديد المؤهل التعليمي المطلوب للترشح لكل مجلس نيابي حيث نص قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم (140) لسنة 2020 علي أنه (يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب (4) أن يكون حاصلا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل) بينما نصت المادة (9) من قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020 علي أنه ( يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ (4) أن يكون حاصلا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل ) بما يعكس التزاما مطلقا بالحدود التعليمية الدنيا التي أقرها النص الدستوري.
المؤهل التعليمي
ثالثا : أن المشرع الدستوري كان دقيقا للغاية في تحديده للمصطلح الخاص بالحد الأدنى للمؤهل التعليمي الواجب للترشح لمجلس النواب والذي نص علي كونه ( شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل ) حيث حددت المادة رقم (4) من قانون التعليم المصري (139) لسنة 1981 المقصود القانوني بماهية هذا التعريف ضمن تحديده لمدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي حيث عرف مرحلة التعليم الأساسي بكونها (تسع سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي ويتكون من حلقتين ( الحلقة الابتدائية) ومدتها ست سنوات و(الحلقة الإعدادية) ومدتها ثلاث سنوات) بما يعني أن المشرع الدستوري حين كان يصيغ النص واعيا بمحدداته الزمنية ومقصوده الفعلي دون لبس أو رغبة في القفز به لمراحل تعليمية مختلفة وإلا كان قد تركه مفتوحا علي غرار ما فعل في المواقع القيادية التنفيذية التي تركها للتنظيم القانوني.
رابعا: أن المشرع وهو يعمل علي صياغة النصوص الدستورية كان دقيقا في صياغاته متمايزا في تحديد مدلولاتها بما لا يمكن معه الظن بإمكانية التفسير أو التلاعب الذي يقفز علي الغايات والأهداف التي سعي النص لضمان الوفاء بها، وهو ما ظهر عند تحديد الحد الأدنى للمؤهل التعليمي المطلوب كمسوغ للترشح بما يشهد بوجود تباين واختلاف واضح في المعني بين مصطلح ( التعليم الإلزامي ) وبين مصطلح (مرحلة التعليم الأساسي) حيث وردت ( الأولي ) في موضعين داخل الدستور ضمن الفقرة الثانية من المادة (19) والتي نصت علي أن ( والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقاً للقانون ) وعادت لتتكرر ضمن الفقرة الثانية من المادة ( 238 ) والتي نصت علي أنه ( وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتي تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2017 / 2016 ) بينما في المقابل ورد مصطلح التعليم الأساسي ضمن المادة ( 102 ) بالنص علي أنه ( ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ) بما يقطع بأن وعي المشرع ومقصوده من الألفاظ يشهد بكونه قد قصد المغايرة بها ولو كان يقصدهما كتعريف لمحدد تعليمي واحد لكان قد استخدم مصطلح واحد منهما وليس الاثنين.
أحكام دستورية
خامسا: أن الأحكام الدستورية المتعلقة بالحالات المشابهة من غموض المصطلح وتداخل معانيه عند صياغة النص القانوني المكمل للدستور قد أقرت مبدأ تدقيق إرادة المشرع وعدم تجاوزها عند تفسير أو صياغة النصوص وهو ما يمكن قراءته بمراجعة الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ( 24 ) لسنة ( 37 ) دستورية بتاريخ 7 مارس 2015 والذي أقرت عبره أحد المبادئ المرجعية الهامة بقولها بأن قضاء المحكمة الدستورية العليا ( قد جري علي أن تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضا فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه الأخرى وإنما متساندا معها بما يقيم بينها التوافق وينزي بها عن التعارض فالأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجا متآلفا )
وفيما يتعلق بالتوسع في تفسير منطوق النصوص الدستورية واستنتاج مقصودات تتجاوز ما تضمنه النص من ضوابط وهو ما سبق ووقع عند تحديد موقف مزدوجي الجنسية من الترشح للمجالس النيابية حيث تضمنت حيثيات الحكم في دستورية قانون مجلس النواب وقتها النص علي أنه ( يتبين مما تقدم أن المشرع الدستوري قد غاير في شرط حمل الجنسية المصرية بالنسبة للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية ومن يعين رئيسا لمجلس الوزراء باشتراطه ألا يكون أيهما يحمل جنسية دولة أخري وإسقاط هذا الشرط بالنسبة للمترشح لعضوية مجلس النواب فمن ثم كان علي المشرع العادي الالتزام بحدود وضوابط ممارسته التشريعية وبمراعاة مراتب التدرج التشريعي فإذا ما خرج عنه وأحل نفسه موضع المشرع الدستوري وأضاف للنص المطعون فيه قيدا وشرطا جديدا بالانفراد بالجنسية المصرية فإنه يكون قد انطوي علي مخالفة لنصوص المواد ( 87 / 88 / 102) من الدستور مما يستوجب القضاء بعدم دستوريته في النطاق المحدد سلفا) .
أزمة حقيقية
سادسا : أن إثارة مسألة رفع الحد الأدنى للمؤهل التعليمي اللازم للترشح لمجلس النواب في ضوء التفسير القانوني للمقصود بمصطلح (شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي) باعتبارها تمتد للمرحلة ( الثانوية ) بديلا عن ( الإعدادية ) يتبدي من الوهلة الأولي وكأنه يعكس أزمة حقيقية يعاني منها مجلس النواب وتنعكس علي أداءه رغم أن الواقع والتحليل الرقمي لبيانات النواب ومؤهلاتهم يقول بغير ذلك ـ وربما بعكسه ـ علي المستوي الوقائعي.
حيث تشير تدقيقات المؤهلات التعليمية للنواب من واقع البيانات الواردة في دليل ( بيانات السادة النواب 2024 ) الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب لأن عدد النواب الذين يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي باعتبارها تعبر عن (المرحلة الإعدادية) يبلغ عددهم ( 8 ) نواب فقط بنسبة ( 1,6 ٪ ) من إجمالي أعضاء مجلس النواب بينما يبلغ عدد حملة الثانوية العامة ـ وما في مستواها ـ من نواب المجلس (70) عضو موزعين بحسب طبيعة المؤهل التعليمي حيث يبلغ عدد حملة الثانوية العامة (11) عضو والثانوية الأزهرية (3) أعضاء مقابل عضو ( واحد ) يحمل شهادة الثانوية الزخرفية .
بينما حملة الدبلومات المتوسطة باعتبارها معادلة للثانوية العامة فقد توزعوا بين دبلوم المدارس الفنية والصناعية (23) عضو ودبلوم المدارس التجارية (19) عضو ودبلوم المدارس الزراعية ( 9 ) أعضاء ودبلوم المعلمين (4) أعضاء في تحليل رقمي يعكس هشاشة الطرح وعدم تأثيره الفعلي علي أداءات المجلس وما يستوجبه من تعديلات علي التشريعات الوطنية بما سيستتبعه من التزامات وإنفاق في الموازنة العامة.
قفز علي الحقائق
سابعا : أن التبريرات التي يسوق لها البعض من أن سبب الضعف في الأداء البرلماني هو وجود نواب يحملون شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) هو قفز علي الحقائق وتلاعب غير مقبول بالوقائع المتعلقة بتقييمات الأداء الفعلي لنواب حيث تشير الأرقام المدققة لكون حملة المؤهلات العليا يمثلون نسبة كاسحة ومسيطرة علي التركيبة البرلمانية حيث يبلغ حملة شهادات ( الدكتوراة ) عدد ( 87 ) نائب فيما يبلغ عدد حملة شهادات ( الماجستير ) وما في حكمه من دراسات تكميلية عدد ( 166 ) نائب بما يجعل أي حديث عن طبيعة المؤهل أو ربط كفاءة الممارسات التشريعية والرقابية بارتفاع المؤهل التعليمي أو تمايز الدرجة العلمية أمر مردود عليه بل وتحمل العديد من الوقائع الموثقة أداءات كارثية للبعض من أصحاب الشهادات العليا الذين مثلت مواقفهم واستخدامهم للأدوات الرقابية والتشريعية سببا في ارتفاع نسب السخط الشعبي وتدني لمستويات شعبية البرلمان.
تاريخ برلماني
ثامنا : يشير التاريخ البرلماني للدولة والذي يمتد لأكثر من قرن ونصف من الزمان إلي أن العمل النيابي والبرلماني لم يرتبط في يوم من الأيام بطبيعة المؤهل التعليمي ـ رغم أهميته ـ بل ترتبط بمدي كفاءة الشخص للقيام بمهامه واستعداده للتطور وبناء المهارات الذاتية التي تتناسب مع سياقات الممارسة وهو ما يمكن تتبعه تاريخيا عبر مواقف وممارسات العديد من النواب الذين تحولت سلوكياتهم لسوابق برلمانية مهدت الطريق لتقنين قواعد الرقابة علي السلطة التنفيذية والتي بدأها عضو مجلس شوري النواب عن مدينة طنطا العمدة عثمان الهرميل أو معارض للحكومة في تاريخ البرلمان المصري أو بالنسبة للمعارض البرلماني الأشهر في نهايات عصر مبارك وهو النائب البدري فرغلي الذي كانت استجواباته للوزراء وكبار المسئولين نموذجا خلدته ذاكرة المصريين رغم آنه كان عاملا للشحن والتفريغ في ميناء بورسعيد أو حتي بالنظر للرموز الفكرية مثل عباس محمود العقاد الذي قاد مسارات الاستنارة والتنوير وكان عضوا في مجلس النواب وفي مجمع اللغة العربية دون أن تتجاوز مؤهلاته الابتدائية ومثلهم الكثير من قادة الفكر والتحرر الوطني في تاريخ مصر الحديث فهل نلغي تاريخ هؤلاء جميعا لمجرد أن البعض يعتبر شهاداتهم العلمية لا ترقي للتواجد وتمثيل الجماهير. وكذلك النائب عبد المنعم العليمي نائب طنطا وشيخ المستقلين فكري الجزار نائب قطور وغيرهم كثيرا كانت لهم تواجد وجولات ومشاركات واستجوابات وتعديلات على تشريعات نالت موافقة الأغلبية حينا ذك …..الخ تاسعا : أن البعض يتساهل في التعامل مع مسألة تعديل المادة رقم ( 4 ) من قانون التعليم رقم ( 139 ) لسنة 1981 باعتقاد أن أثرها المباشر سيتوقف فقط عند تعديل اشتراط الترشح لعضوية مجلس النواب وهو فهم قاصر وكارثي كونه يصدر عن نخبة نيابية يفترض أن أحد أدوارها الرئيسية هو دراسة الآثار التشريعية المترتبة علي إصدار أو تعديل التشريعات القائمة حيث أن التعديل الذي يقترحه البعض لتعريف مرحلة التعليم الأساسي سيترتب عليه إعادة صياغة كاملة للهيكل التنفيذي لوزارة التربية والتعليم وموازناتها المالية ولوائحها المنظمة وهو أمر لا يستطيع هيكل الوزارة أو لوائحها التعامل معه بل ويتعارض مع الكثير من القرارات والرسوم المتعلقة بالخدمات التعليمية وفي مقدمتها القرار الوزاري رقم ( 162 ) بتاريخ 12 سبتمبر 2024 بتنظيم إعادة القيد بين طلاب مدارس الثانوي العام والفني الرسمي ( عربي ـ لغات ) والمدارس الخاصة بأنواعها ( عربي ـ لغات ) فضلا عن كونه سيحمل الموازنة العامة بتكاليف وأعباء تزيد من مواطن الخلل والعوار رغم كل محاولات العلاج آو الالتفاف التي تصاحبها في كل عام
. في النهاية تبقي قضية الحوار وتبادل وجهات النظر حول ضوابط الترشح وضمانات الكفاءة والممارسة البرلمانية وما يتفرع عنه من قضايا تمس طبيعة النظام الانتخابي والعدد الأنسب لعضويته دليلا علي أهمية الغرفة التشريعية ذات الطابع الرقابي والرغبات المجتمعية لتطوير أداءاته وبما يتسق والآمال المعقودة عليه كملف مستدام ومستحق للمزيد من الحوار وطرح وجهات النظر والنقاش حولها دون استخدام الأغلبية الميكانيكية لتمرير تشريعات مجحفة ترسخ لمصالح نفعية يتكتل البعض لضمان بقائها ولو علي حساب الوطن ومستقبله .
ومن المبادئ العامة المستقرة أن فهم وإعمال كل نص إنما يدور في إطار الوحدة الموضوعية للدستور وفى إطار القواعد العامة للتفسير التي تعطى الأولوية للتفسير الذى يتيح إعمال سائر النصوص ،على تلك التفسيرات التي قد تؤدى إلى إهمال بعضها. وهو ما سبق وأن قننته أحكام المحكمة الدستورية العليا في السابق وتضمنه الدستور الحالي بوضوح في المادة 227منه.
فقد سبق أن قطعت المحكمة الدستورية بأنه “من المسلم به أنه ينبغي عند تفسير نصوص الدستور النظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضا بحيث لا يفسر أي نص منها بمعزل عن نصوصه الأخرى بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً معها يفهم مدلوله فهماً يقيم بينها التوافق ويمنع التعارض، وأن “التكامل بين النصوص الدستورية مؤداه امتناع تعارضها وتماحيها،وتجانسها لاتهاترها ضماناً لتحقيق المقاصد التي ترتبط بها فلا يكون أحدها ناسخاً لسواه” وقد قننت المادة 227 من الدستور هذا الوضع فى نص غير مسبوق فى الدساتير المصرية السابقة حيث نصت على أن “يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا, وكلاً لا يتجزأ, وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة”.
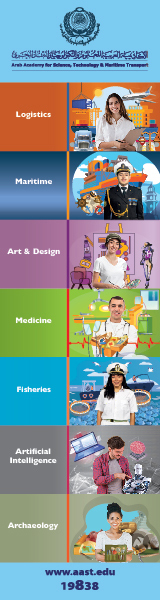
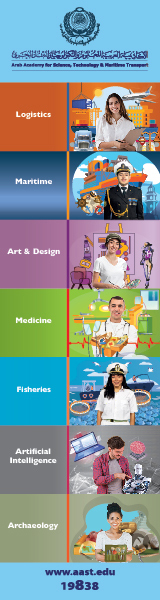
 جريدة هرم مصر حقيقه بدات
جريدة هرم مصر حقيقه بدات