أن لغة المسرح هي من أقوى اللغات الإبداعية، فهو فن المواجهة الحقيقي ضد الزيف وكل ما يسلب الحرية أو يحاول المساس بها، المسرح فن ضد التعصب وضد الصيغ الجامدة، سواء في الحياة أو على مستوى التقنيات الفنية التي يقوم عليها العمل المسرحي، فالمسرح هو فن المغامرة والبحث عن صيغ تجريبية دائماً، لذا نراه عبر تاريخه الطويل قد تعددت أشكاله من خلال طرق متنوعة في الأداء والتأليف والإخراج، ويكاد يكون هو أكثر الفنون كسراً للنمط، فالتجريب ينطلي من خلال الوعي المتمرد ذي الرؤية النسبية الذي ينطلق نحو هدف محدد، وهو المساهمة في صنع ثقافة وطنية وهوية خاصة تقوم على أسس من الحرية والعدل والمساواة،
وكذلك قيامه على شرط الإبداع لا الاتباع. أن المسرح يستطيع مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، ودون عبر صفحته الشخصية قائلا: “لو كان الأمر تم وأخذنا مسرحا أنا والشباب المتعطش للمسرح، كان من الممكن تغيير الفكر المتطرف لهؤلاء الذين يواجهوننا بالنار والدمار، فالمسرح له دور عظيم في مواجهة الإرهاب، بخلاف أن أبسط شباب جيلنا في مقدورهم عمل من الخراب مسرحا”. لم يكن المسرح العربي يعرف في زمن ما معنى «أزمة» مثلما يعرفها الآن،
على الرغم من كثرة ترديد المسرحيين لهذه الكلمة. فعلى مدار تاريخه منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى وقتنا الراهن والمشتغلون في مجال المسرح يتحدثون عن وجود أزمة في المسرح، ربما تمثلت في قلة النفقات، وربما في ندرة خشبات العرض، أو حتى تفتت الفرق الكبرى ورحيل النجوم والمؤسسين. لكن طيلة الوقت كان ثمة ورق جديد لكتاب جدد، وجمهور كبير يقبل على هذا الفن الذي يمكنه أن يستوعب مختلف الفنون الأخرى، بدءًا من الغناء والموسيقا والرقص إلى الإلقاء والتأليف والوعظ والإلهاء والتثوير، حتى إنه في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي كان هو الفن الجماهيري الأول. واستطاع منافسة السينما والتلفزيون لسنوات طويلة،
حتى إن مسرحية «الزعيم» لعادل إمام ظلت تعرض لأكثر من عشر سنوات على المسرح، وما زالت أعمال سعد الله ونوس ومحمد الماغوط ومحمود دياب وعلي سالم والرحبانية وغيرهم قادرة على إمتاع الناس حتى الآن، لكن السنوات الأخيرة كشفت أن المسرح العربي خرج من المنافسة، ولم يعد قادرًا على إمتاع الجماهير أو جذبهم، وأن تجارب مثل مسرح مصر أو غيرها لم تقدم إلا مزيدًا من التسطيح، وأن فن البسطاء لم يعد قادرًا على التعبير عن همومهم أو ثوراتهم أو مخاوفهم، فهل يعيش المسرح العربي الآن في أزمة، وما أسبابها؟ وكيف يمكن الخروج منها؟
إن التجريب لا يمكن أن يتأصل في بلد يقع تحت هيمنة طائفية دينية، تنفي حق غيرها من الطوائف في الوجود، أو الاختلاف عنها في التأويل، ولا يصل فعل التجريب إلى درجة الحضور في ثقافة تفزع من الآخر، وتتعود فيها الذات النظر إلى المغاير نظرة الريبة، كأنها تختزل الموقف المتعصب للقطر المنغلق على نفسه، ذلك الذي ينظر إلى الأقطار المختلفة نظر التوجس المستريب، ولن يصل فعل التجريب إلى حده الأدنى في المجتمع الذي يقمع العقل، أو تكون السيادة للتقليد على الاجتهاد، والاتباع على الإبداع، والتعصب على التسامح، والتمييز على المساواة، والتصديق على المساءلة والإجابة المطلقة عن السؤال المفتوح. إن المسرح له دور كبير في مواجهة الفكر المتطرف، وما أحوجنا إلى هذا الدور البناء والفعال خاصةً ونحن في ظل هذه الظروف الحرجة، التي يمر بها وطننا العربي، ومن هنا ندعو الأشقاءَ في المنطقة العربية والعالم أجمع إلى تسخير الجهود والإمكانات لخدمة هذا الهدف، وهو مواجهةُ الإرهاب ، ودعم المسرح ليشارك في المواجهة ضد قوى التطرف.
إن الحاجة ملحة في الوقت الحالي إلى الاهتمام بالمسرح في الجامعات والمسارح وقصور الثقافة، ونتطلع إلى استكمال خطة مسرحة المناهج كمنهاج تربوي أساسي لتنمية فكر الناشئة على أسس منفتحة تنويرية تحول دون تأثير الفكر المتطرف عليهم.
أن المسرح كان دائماً وعبر تاريخه رسالة مفتوحة للحرية ونشر القيم الإنسانية الرفيعة، وقد عرف المسرح العربي في الثلاثين عاماً الماضية مجموعة من العروض المسرحية المهمة التي واجهت الإرهاب بخطاب مسرحي مستنير، ومن أهم هذه العروض مسرحية «الزهرة والجنزير» لمحمد سلماوي والتي نشرها لأول مرة عام 1992، وبدأ عرضها على خشبة المسرح المصري عام 1996، وهي مسرحية تنطوي على شجاعة المواجهة لظاهرة الإرهاب الخطرة،
والكشف عن الأسباب التي أدت إليها، وتجسد الشخصيات التي يصل بها التطرف والتعصب إلى العنف العاري، وتمثيل خطاب الإرهاب بما يضع هذا الخطاب موضع المساءلة في عقل المتفرج الذي لا يمكن أن يتلقى هذه المسرحية تلقياً سلبياً، فالمسرحية تنطوي على وجهة نظر خاصة بها، وتدفع المتفرج إلى اتخاذ موقف نقدي من دلالة الأحداث التي تمثلها،
فالأهم هو مشاركة المتفرج مع وجهة نظر المسرحية في إدانة الإرهاب، وتأمله بواسطتها الأسباب التي أدت إليه. أن الدولة تعي تماما أهمية الثقافة ودورها في مكافحة التطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة حوله، وهو ما جعلها تحرص في مخططها التنموي للنهوض بالخدمات ومستويات المعيشة في القرى والمدن الأكثر احتياجا (مبادرة حياة كريمة)، على أن تتضمن كل وحدة منها (بيت للثقافة) يتيح للأهالي ممارسة أنشطتهم الإبداعية واكتشاف المواهب بينهم،
بالإضافة لتحجيم تأثيرات الإرهاب الفكري والقيم المغلوطة التي تسعى جماعات التطرف لنشرها، باعتبار أن تأثيرات الدراما والأبداع الفني في مكافحة التطرف بالغة الفعالية والنجاح، نظرا لدور الفن الساحر في تهذيب المشاعر والأحاسيس والتأثير في وجدان متلقيه،
قدر غياب الفن في مواجهة ظاهرتي الإرهاب والتطرف في فترات سابقة بقدر ما نجح في تفكيك خطاب هاتين الظاهرتين خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا ما يمكن رصده بتحليل تأثيرات وتفاعل الجماهير مع الإنتاج الدرامي المصري مع دخوله لهذا المجال عبر العديد من الأعمال الفنية والدرامية الحديثة. أننا نحتاج قرارا جريئا من وزارة الثقافة مدعومة من وزارة المالية لإعادة تأهيل المسارح الموجودة حاليا كي تكون مكانا آدميا لأن تحويل المسرح إلى سلعة في القطاع الخاص أفسده،
وإذا كانت الدولة مثقلة بالديون فعلى رجال الأعمال الذين يلعبون دورا ثقافيا في المجتمع دعم المسرح إذ من الممكن أن تخصص ميزانية لإنشاء مسارح جديدة، وإقامة مهرجانات عالمية مسرحية لدعم المسرح والسياحة في نفس الوقت. المسرح يمثل الثقافة، لكنه قاوم في فترة السبعينيات أثناء فترة ظهور الجماعات الإسلامية، وشرد الرئيس الراحل «السادات» كثيرًا من المسرحيين والمثقفين، لدرجة أنهم هاجروا إلى الخارج، وكان من أمثال هؤلاء المسرحيين سعد أردش وألفريد فرج، ونقل كثيرًا منهم إلى وظائف أخرى بعيدًا عن التأثير المسرحي كل البعد. وعاصرت هذه الفترة وقدمت مجموعة من الأعمال المسرحية التي تناقش قضايا محاربة الإرهاب والتطرف، إلا أنها لاقت الرفض من جميع أدوار العرض المسرحية خوفًا من تقديمها، مثل مسرحية «أمير الحشاشين» في ظل تولي عبدالغفار عودة رئاسة المسرح الاستعراضي.
وأيضا مسرحية «الحادثة التي جرت» وقدمت على المسرح القومي، والتي تدور أحداثها حول أحداث ١١ سبتمبر والإرهاب العالمي، لكن رفضها شريف عبداللطيف، وغيرها من المسرحيات التي لاقت الرفض لخوف المسرحيين ذاتهم. ومطلوب من المسرحيين أن يكونوا على قدر المسئولية وتحملها مواجهة هذه المخاطر التي تلاحق المجتمع المصري.
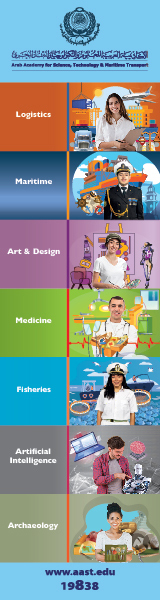
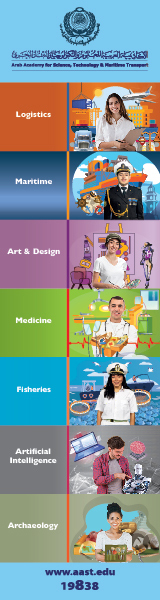
 جريدة هرم مصر حقيقه بدات
جريدة هرم مصر حقيقه بدات



